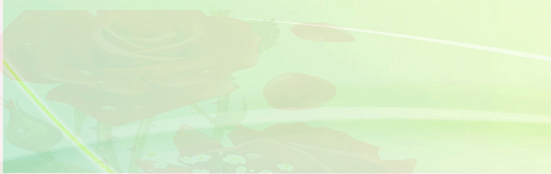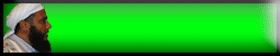| العدالة الاجتماعية الجزء الأول |
|
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد فإن الله عز وجل خلق هذه الأرض وما فيها لمصلحة بني آدم، فهيأ لهم فيها وسائل العيش، وجعلها كفاتا أحياء وأمواتا، وجمع فيها من أنواع الأرزاق وأنواع ما تحتاج إليه البشرية ما لا يمكن أن ينفد حتى تنفد البشرية، وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، ومن أجل هذا فإن الله سبحانه وتعالى كان من بدائع لطفه حين نشر البشرية في هذه الأرض وعلم بأعداد البشرية الهائلة التي تزداد على الزمن وتتضاعف خلق الموت ليعين به على نقص هذه الأعداد حتى تتسع الأرض لأهلها، ولو لم يخلق الله الموت لامتلأت الأرض ببني آدم ولأخذوا ما فيها من الخيرات واستوعبوا ما فيها من الطاقات ولم يستطيعوا بذلك الاشتراك في العيش في هذه الحياة الدنيا، ولكن الله خلق الموت لهذه الحكمة البالغة، ثم لو أنه أعلمهم بالموت ولم يخلق لهم الأمل لضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى لو اتسعت وكثرت الأرزاق فيها لأن من علم أن وراءه الموت يرصده لا يمكن أن يطيب له عيش، لكنه خلق لهم الأمل فلا يزال الإنسان يؤمل الحياة حتى وهو في السياق والنزع، فيؤمل أن يعيش فبذلك يكتسب ويقدم شيئا للذين يعيشون على هذه الأرض من بعده، والله سبحانه وتعالى جعل الناس ثلاثة أنواع، النوع الأول لا يستطيعون اكتساب أرزاقهم ولا يقدرون عليها فهم عاجزون إما عجزا كاملا وإما عجزا ناقصا فليس لديهم من الطاقات ما يتحملون به اكتساب أرزاقهم وحاجياتهم، النوع الثاني ساوى الله تعالى بين ما ءاتاهم من الطاقات وبين حاجاتهم، فلديهم من الطاقات ما يستوعب حاجاتهم ولا يزيد عليها شيئا، النوع الثالث آتاه الله من الطاقات أكثر من حاجاته، فهو ينتج لغيره، وجعل الله سبحانه وتعالى بتدبيره هذا الصنف محتاجا إلى الأصناف الأخرى لا يستطيع أن يمن عليها، وجعله بأمله يفكر التفكير الذي يعيش فيه القرون وراء القرون، فالمنتج لا ينتج لعمره فقط، ولو كان كذلك لما أنتج المبدعون الذين أتوا بإبداعات كان لها ما وراءها في تاريخ البشرية، لأنهم إنما ينتجون حسب حاجتهم فقط، ولكن لتدبير الله تعالى وهذا الأمل الذي خلقه فإن هؤلاء يفكرون لزمن غير محدد، ومن هنا ينتجون إنتاجا غير منقطع، ثم إن الله سبحانه وتعالى ضمن لآدم في الجنة أربعة أمور وهي أصول المنافع، فقال تعالى: {إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى} وهذه أربعة أمور هي ضروريات البشر، فأولا: إن لك أن لا تجوع فيها فهذا يسد ضرورة الطعام، ثم قال: ولا تعرى وهذا يسد ضرورة اللباس، ثم قال: وإنك لا تظمأ فيها وهذا يسد ضرورة المشرب، ثم قال: ولا تضحى أي لا تبرز للشمس فهذا يسد ضرورة السكن، وهذه الأربع هي أمهات ضروريات البشر مطلقا، ثم أضيف إليها بعد هبوط آدم إلى هذه الأرض وخروجه من الجنة هو وحواء بعد أن بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أضيف إليها حاجة الإنسان إلى جنسه ليكون ذلك مدعاة لاستمرار النسل فكان ضرورة خامسة ليست مضمونة في الجنة وإنما هي لأهل الأرض، وهذه الضرورات ما وراءها ينقسم إلى قسمين، إلى حاجيات وإلى تحسينيات أو تكميليات وكل ذلك يحتاج إليه البشر، لكن حاجتهم إلى الضروريات أعظم من حاجتهم إلى الحاجيات، وحاجتهم إلى الحاجيات أعظم من حاجتهم إلى التكميليات، ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى جعل الضروريات ميسرة مهيأة في جميع الأزمنة، منذ عهد آدم إلى زماننا هذا والهواء الأكسجين الذي يتنفس الناس به فوق الأرض وهو ميسر سهل، ولو أنه كان مثل المعادن النفيسة التي تحتاج إليها البشرية لكان محتاجا إلى طاقة وبذل وجهد فيموت عدد كبير من الناس لا يستطيعون الوصول إلى تلك الطاقة ولا إلى ذلك الجهد، ولكن الله علم حاجة الجميع إليه فيسره لهم فوق الأرض، وكذلك الحاجة إلى الماء جعل الله على الأرض مسطحات مائية تكفي لسقي الناس وجعل في الصحاري طبقات من الأرض تمسك المياه التي تدخل في أجواف الأرض وتصفيها، وجعل الجبال ذات طاقة لتصفية المياه وإخراج أملاحها وإخراج ما فيها من المضار لتكون مهيأة لشرب البشرية، وكذلك أنبت على هذه الأرض من أنواع الأشجار والثمرات والخيرات ما جعل البشرية وغيرها من الحيوانات التي تعيش على هذه الأرض يستطيع أن يستغني بذلك حتى قبل التصنيع وقبل الاختراعات، فهذه الضروريات لم تكن محتاجة إلى كبير تفكير ولا إلى كبير اختراع، منذ بدأت البشرية وهي تعرف كيف تبني من الحجارة بيتا يكنها من الحر والبرد، وهي تعرف كيف تفلح الأرض وتزرع فيها، وهي تعرف كيف تتناول الماء وتستخرجه من الأرض فهذه ضرورات يسرها الله، ولا شك أن كثيرا منكم يتعجب إذا علم أن الماء مصنف في جنس المعادن، وهو كغيره من المعادن النفيسة لكنه ما وجد في مكان في أعماق الأرض إلا وقد اكتشفته البشرية فيما مضى، والمعادن الأخرى تحيط به من كل جانب لا ينظر إليها أحد ولا يكتشفها، فكثير من آبائنا وأسلافنا كانوا يكتشفون المياه في أعماق الأرض ويعرفون أماكن وجودها، ويحيط بهذه المياه أنواع المعادن النفيسة لا يطلعون عليها ولا يستطيعون الوصول إليها، وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى حين علم حاجة الناس إلى اللحوم والألبان ومشتقاتها أنزل ثمانية أزواج من الأنعام من الجنة فكانت أصول الأنعام في هذه الأرض، ثم أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فكان أصل الصناعات كلها، وعلم آدم الزراعة فكان ذلك أصل الفلاحة والزراعة كلها، فكانت هذه الأمور كفيلة بضمان البقاء والعيش على سطح هذه الأرض، ولله تعالى من الكواكب الأخرى في مجموعتنا الشمسية وفي غيرها أضعاف الأرض لم يجعل عليه هذه الأرزاق ولم يضع فيه هذه البركات، ومن أجل هذا قال الله سبحانه وتعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} بعد قوله: {قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ} فلاحظوا أنه ذكر أربعة أنواع من الخلق في العالم السفلي تقابلها أربعة أنواع من الخلق في العالم العلوي، وذلك للتوازن بين هذين السقفين السقف الوطاء والسقف الغطاء، فجعل بينهما توازنا بديعا عجيبا فقال: {قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ} فهذا خلق لقشرة الأرض وما فيها، ثم قال: {وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا} وهذه الجبال وفيها من الفوائد للبشرية الأشياء العجيبة جدا، فهي التي تمنع الأرض أن تميد بكم، وهي التي يستدل بها الناس ويهتدون بها، وهي التي تخزن المياه وتصفيها، وهي التي تحتوي على المعادن النفيسة في قلوبها، وهي كذلك مدعاة للتمنع من العدو وللاستتار عن أعين الحيوانات المفترسة فكل ذلك من فوائد هذه الجبال، ثم قال بعد هذا: {وَبَارَكَ فِيهَا} وهذه البركة التي في الأرض هي التي أخرجت ثمراتها وأنبتت أشجارها وجعلت فيها المعادن النفيسة والثمار الطيبة، {وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ} وهذا النوع الرابع من أنواع الخلق في العالم السفلي، هي أنه قدر فيها أقواتها، فهيأ في كل أرض من الأقوات ما يحتاج إليه سكانها، فالصحاري التي يقل سكانها تقل الثمرات فيها والزروع، والأراضي المكتظة بالسكان تكثر فيها الأنهار وتكثر فيها الأشجار وتكثر فيها الزروع، وهذا تدبير العزيز العليم، الذي يعلم الأماكن التي تصلح لاستقرار البشرية ويجلب إليها النفوس التي تناسب تلك الأرض، فبعض البيئات شديدة الحرارة يجلب إليها أقواما يصلحون لهذه البيئة، وبعض البيئات شديدة البرودة يجلب لها أقواما آخرين يصلحون لتلك البيئة، وبين هذا وهذا أماكن متنوعة يجلب لكل بيئة ما يصلح لها من أنواع البشر، ويكون ذلك مؤثرا حتى في أخلاقهم وطباعهم وألوانهم ولغاتهم، ومن أجل هذا قال الله تعالى: {وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ} فربط بين اختلاف الألسنة والألوان وبين خلق السماوات والأرض مما يدل على أن اختلاف الألسنة والألوان يتأثر بالبيئات وبنمط العيش وبطريقة السكن، فمن أجل هذا ترون تغير الألوان في الأجيال بسبب تغير السكن والبيئة والمعاش، تتغير الألوان وتتغير الألسنة، سواء كان ذلك بالتغير الكامل كما يحصل في الانتقال من اللغات، فأصل اللغات لغات محصورة، قال ابن عباس هي خمس وسبعون لغة، ولكنها تنوع منها من اللغات ما لا يعلمه إلا الله، فشبه الجزيرة الهندية وحدها فيها أربعمائة وثمانون لغة يتكلم بها الهنود، أربعمائة وثمانون لغة في منطقة محصورة في دولة واحدة، وكذلك في البلدان الأوروبية التي هي من أضيق البلدان وأكثرها اكتظاظا بالناس عدد كبير من اللغات واللهجات المتباينة، ففي فرنسا وحدها ثلاث لهجات من اللغة الفرنسية، وفي إنكلترا أربع لهجات متباينة، وهكذا، وهذا من التطور الحضاري الذي يقتضي تغير اللغات بالكلية، فاللغات السامية متباينة مثلا، فالفرق بين العبرية والعربية واضح جدا، وكذلك الفرق بين الفارسية والتركية مثلا، وتأثر بعض اللغات ببعض واضح، لاختلاط البيئات كتأثر اللغة الأردية والتركية باللغة العربية، وتأثر اللغة الفارسية باللغة العربية أيضا، ثم إن هذه اللغات لها حركة بطيئة عجيبة تسير مع الزمن، فلو أن أية لغة من اللغات أخذ أهلها قاموسا قديما كان قبل ألف سنة متداولا وأرادوا التفاهم بما فيه من المفردات فيما بينهم لوجدوا ذلك أمرا شاقا عسرا جدا، ومن هنا فإن أشعار الإنجليز قبل مائة سنة لا يفهمها طلاب المدارس اليوم في بلادهم، لأن اللغة تطورت، وبتطور المجازات وتنوع الدلالات يختلف مدلول الألفاظ وبذلك لا تفهم تلك الأشعار، وأركد اللغات اللغة العربية، فإن أولاد العرب إلى اليوم إذا سمع أحدهم قول امرئ القيس: \"قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل\" فإنه يفهم معنى هذا الشطر بسليقته، وإن لم يفهم معنى التركيب بكامله لكنه يفهم الكلمات، وهذا البيت قد قيل قبل مولد النبي (ص) بمائة سنة على الأقل، ولركود اللغة العربية اختارها الله سبحانه وتعالى لكتابه القرآن الذي تقوم به الحجة على من بلغ، فلو أن القرآن نزل بلغة غير اللغة العربية لم يعد اليوم صالحا للفهم، ولأصبح محتاجا إلى كثير من الشروح في كل زمان، لكن نظرا لركود هذه اللغة اختيرت لأن تكون لغة القرآن، لثباتها وندرة التغير في مدلولاتها، ثم إن هذه الأنواع الأربعة من أنواع الخلائق في الأرض قرنها الله سبحانه وتعالى بأربعة أنواع من أنواع الخلائق في العالم العلوي حيث قال: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ} وهذا يقابل قوله: {قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ} إذن هذه السماوات السبع في العالم العلوي تقابلها الأرضون السبع في العالم السفلي، {وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا} وهذا يقابل قوله: {وَبَارَكَ فِيهَا}، وهذا الأمر الذي في السماء محجوب عنا ونحن لا نعلمه، لأنه ليس مهيأ لنا فالسماء ليست مهيأة لأن يسكنها البشر، ومن أجل هذا لم يكتشفوا ما يقارن هذه البركة التي يكتشفونها في الأرض، {وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا} ثم قال: {وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ} وهذه تقابل الجبال في الأرض في قوله: {وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا} فالنجوم في السماء بمثابة الجبال في الأرض ثم قال: {وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} وهذا الحفظ هو المقابل لقوله: {وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا} فهذا الحفظ الذي في السماء يقابل الأقوات التي في الأرض، ومن هنا يستغني الملائكة بالحفظ عن الأرزاق، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبحفظ الله لهم يستغنون عن الأرزاق فليسوا مثل أهل الأرض وسكانها الذين يحتاجون إلى مثل هذه الأرزاق، كان من تدبير الله سبحانه وتعالى أن هذه الخيرات المحجوبة في الأرض، وبالأخص ما يتعلق منها بالحاجيات والتكميليات لا يمكن أن تكتشف في عصر واحد ولا أن تستخرج فيه، إذ لو استخرجت فيه لنفدت احتياجات الناس، والبشرية لا تزال تتمدد وتكثر احتياجاتها، فجعل الله تعالى اكتشاف هذه الخيرات بالتدريج، فنحن في هذه البلاد اكتشفنا معدن الحديد، فعاش الناس زمانا على هذا المعدن ثم بعده تكتشف معادن أخرى، فيمكن أن يكتشف من المعادن ما هو أسهل وأيسر منه كالنفط مثلا أو غيره من المعادن التي يحتاج الناس إليها، وهكذا في كل البلدان، وهذا تدبير العزيز العليم، إن من تدبيره سبحانه وتعالى أن أمم هذه الأرزاق في هذه الأرض ولم يجعلها ملكا فرديا لمكتشفها وإنما جعلها للبشرية، فجعل المال الذي في الأرض ملكا لله سبحانه وتعالى، والبشر مستخلفون فيه فقط، وهذا يقتضي منهم أن لا يبذروا فيه وأن لا يسرفوا، وأن لا يحجروه على أنفسهم وأن لا يمنعوا الآخرين من الانتفاع به لأنه مال الله، والإنسان فيه مستخلف فقط، فهو بمثابة الوكيل ينتظر العزل في كل حين، وعزله إما بالموت فينتقل ويترك ما وراءه كما قال تعالى: {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ} أو بالحجر على يديه فلا يستطيع التصرف في ماله، أو بقهره وسجنه، أو بمرضه مرضا يمنع من التصرف، أو بنقص عقله بكبره وهرمه، أو بغير ذلك من أنواع العزل التي يعزل الله بها من شاء عن التصرف فيما جعل تحت يده من المال، والله سبحانه وتعالى بين لنا أن هذا المال الذي جعل في هذه الأرض ملك له سبحانه وتعالى وليس ملكا لنا، وأنه استخلفنا فيه فقط، فقال تعالى: {وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} ولهذا حين خاطب الملائكة بقوله: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} أي مستخلفا فيما في الأرض من أنواع الخيرات والأملاك، وبين أنه خلق لنا هذا بقوله: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} وهذا ينقسم إلى ثلاثة أنواع إلى ما خلق انتفاعا وما خلق اعتبارا وما خلق اختبارا، فما خلق انتفاعا مثل أنواع الأرزاق التي في هذه الأرض التي ينتفع الناس بها، وما خلق اعتبارا مثل ما في هذه الأرض مما لا ينفع ولا يضر وإنما نراه فنتعظ به كأنواع الحشرات غير السامة وغير الضارة التي إذا حفرنا في الأرض أمتارا نجدها فيها، نجد فيها أنواع الدود وغيره من أنواع الحيوانات التي تعيش في جوف الأرض، ويتعظ الإنسان فيها فيقول: من أين يأتيها الهواء ومن يأتيها الماء وكيف تعيش، وكذلك ما نراه في الصحاري من أنواع الغزلان والوحوش وغيرها، يقول الإنسان: من أين يأتيها الماء وكيف تعيش وما غذاؤها فيتذكر قول الله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ}، وحينئذ سيكون الإنسان متعظا مستفيدا من هذه الحيوانات وغيرها من أنواع ما خلق الله في الأرض فلم يخلق الله شيئا عبثا، كل ما في الأرض لحكمة بالغة {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ}، النوع الثالث ما خلق اختبارا، وهو ما يسلطه الله على الإنسان من أنواع الجراثيم والمكروبات وأنواع الأوبئة الفتاكة، وحتى أنواع الأسلحة الفتاكة التي ييسر لها من يكتشفها ويستغلها فهي خلقت اختبارا للبشرية، فالإنسان يمرض ويصاب بالمصائب ويموت وكل ذلك اختبار له {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا}، فكلها من الاختبارات والابتلاءات العجيبة، إن هذه الأرزاق إذا علمنا أنها مملوكة لله سبحانه وتعالى فإن علينا أن لا نبذر فيها وأن نعدل في توزيعها وأن لا نحتكرها، وأن لا ندخرها لأنفسنا دون من سوانا، وهذه هي الأسس التي قام عليها الاقتصاد الإسلامي، فكل مشروع حضاري أيا كان لا بد أن تظهر نظرته للموضوعات الحساسة التي يعيشها الناس، وإن من الموضوعات الحساسة التي يعيشها الناس موضوع الاقتصاد، وإن النظرة الإسلامية للعالم كله مشروع حضاري متكامل فمن أجل ذلك اقتضى بيان أوجهه المختلفة وبالأخص الكلام في الموضوعات الحساسة مثل موضوع اقتصاد البشرية، فلذلك لا بد أن يظهر للمسلمين رأي بارز ونظرة موضوعية حيال هذا الاقتصاد وحيال اكتسابه وحيال توزيعه، فإن الطاقة التي في الأرض والنفع الذي فيها كما ذكرنا ملك للجميع، يدخل فيه المؤمن والكافر فليس للمؤمن أن يحتكر الخيرات ويمنع الكافر منها، ولهذا نص العلماء على أنه لا يجوز له إذا لم يجد من الماء إلا ما يكفي لوضوئه أو لشرب كافر أو كلب عقور أو حيوان غير محترم لا يحل له أن يميته بالعطش ويتوضأ بذلك الماء، بل إما أن يسقيه ويتيمم أو أن يقتله ويتوضأ بالماء بعد قتله، وذلك أنه مشارك في هذا الماء له حق فيه، وهذا يشمل جميع الحيوانات حتى قد ثبت في الصحيحين عن رسول الله (ص) أن بغيا من اليهود غفر الله لها ذنبها بسبب كلب مرت به عند بير يلهث ويأكل الثرى من العطش فنزلت ونزعت موقها فاغترفت به من الماء وأمسكته بفيها حتى صعدت وسقت الكلب فغفر الله لها، وكذلك ثبت عن رسول الله (ص) أنه قال: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، فهذا يقتضي اشتراك كل أنواع الحيوانات في هذه الأرزاق التي خلقها الله في هذه الأرض وانتفاع الجميع بها، ومن هنا فإن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومنهم نسأل الله السلامة والعافية مغاليق للخير مفاتيح للشر، فالذين هم مفاتيح للخير يفتحون أبوابا لأنواع الأرزاق والانتفاعات ينتفع بها المؤمن والكافر والحيوان البهيمي وغير ذلك، ومنهم مغاليق للشر يغلقون أبوابا فيها مضرة تهلك الحرث والنسل وتقضي على أنواع الكائنات الحية سواء كانت من الحيوان أو من النبات، ومنهم عكس ذلك من هم مغاليق للخير يجدون بابا واسعا يعيش منه الناس فيفعلون ذنبا يزول به ذلك الباب، وكم من قوم كانت أمورهم مستقيمة وكانت حياتهم طيبة، فجاء أصحاب الذنوب فأذنبوا وأسرفوا فأغلق الله باب ذلك الخير الذي كانوا يعيشون منه، وأنتم تقرءون في سورة سبأ قصة أصحاب سبأ الذين فتح الله لهم أنواع الأرزاق في هذه الأرض ويسر لهم سبل الانتفاع بها وهون عليهم الانتقال ويسر لهم السبل ولكنهم بغوا وطغوا فبدل الله ذلك وأهلكهم على يد أضعف خلق الله على يد هرة، فأهلكهم الله بذلك وفرقهم أيادي سبا وجعلهم خبرا بعد عين، وكذلك الحال في الأمم التي طغت في البلدان كلها، فعادٌ الذين بسط الله لهم أنواع الأرزاق، وزادهم بسطة في أجسامهم على قوم نوح وأطال أعمارهم ومع ذلك حين بغوا وطغوا أرسل الله عليهم الريح ثمانية أيام حسوما، فقضت على الأخضر واليابس في بلادهم، وما زالت بلادهم إلى اليوم لا يستطيع أحد السير فيها، وإذا سارت فيها سيارة وأرادت المنقلب في نفس الساعة تضيع أثرها ولا تهتدي إلى المكان الذي خرجت منه، وبلادهم اليوم بلاد الأحقاف هي المعروفة بالربع الخالي في جزيرة العرب، وما زالت الريح مستمرة فيها على أثر تلك الريح التي سخرها الله ثمانية أيام حسوما، وكذلك ثمود الذين يسر الله لهم أنواع الأرزاق وجعل لهم الجبال بيوتا حين بغوا وطغوا أرسل الله عليهم هذه الصيحة التي أهلكتهم وشقت شغاف قلوبهم، فلم يستطع أحد منهم أن يصمد أمامها فهلكوا جميعا في لحظة واحدة، وكذلك قوم لوط ومن سواهم من الأمم، والذين كانوا يعيشون في نقطة التوازن بالعالم بمكة شرفها الله وحرسها كانوا إذا بغوا في الحرم يسلط الله عليهم ما يهلكهم ويبيدهم، فعندما يسر الله تعالى لإبراهيم مكان البيت بوأ الله لإبراهيم مكان البيت وأمره أن ينزل عنده أمته وولده وأراه مكانه أخرج الله بهذا الوادي الموحش الذي لا زرع فيه: {بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ} هذا الماء الطيب الذي لم يزل إلى يومنا هذا يسقي الحجيج الأعظم وهو ماء زمزم، فساكن هاجر في ذلك المكان العمالقة، ولكنهم حين بغوا فيه سلط الله عليهم جرهم، فقتلوهم قتل عاد وإرم وأخرجوهم منه، ثم حين بغى جرهم أهلكهم الله أيضا وسلط عليهم الذين جاءوا من سد مأرب كخزاعة وغيرهم، ثم لما بغى خزاعة في الحرم سلط الله عليهم قصيا فأخرجهم، واستمر ذلك في زمان الجاهلية كله، ولهذا تقول امرأة من قريش لولدها: أبني لا تظلم بمـ ** ـكة لا الكبير ولا الصغير أبني قد جربتها** فوجدت ظالمها يبور الله آمنها وما** بنيت بساحتها القصور ولقد غزاها تبع** فكسى بَنِيَّتَها الحرير يمشي إليها حافيا** بفنائه ألفا بعير والله آمن طيرها** والعصم تامن في ثبير فلما جاء الإسلام وكان الحكم في الجاهلية والردع عن طريق القوة الباطنية جاء الإسلام فظهرت القوة الحسية الواقعية فرفع ذلك العقاب كما قال ابن عباس، قال: إن العقاب الذي كان يأتي أهل الجاهلية في جاهليتهم كان عقابا باطنيا، فلما جاء العقاب الظاهري بشرع الله عز وجل رفع الله العقاب الباطني، فكان في الجاهلية الذئب يطرد الأرنب حتى تدخل الحرم فيرجع ويتركها، واليوم أصبح الناس يتجرءون على معاصي الله في حرمه ويقتلون ويقومون بأنواع الجرائم، فلا يرون بعض تلك الآيات التي كان يراها أهل الجاهلية، وذلك لما ردع الله بهذا الدين وبما شرع في كتابه المبين من أنواع الزواجر التي تكفي أهل الإيمان وتردهم عن الطغيان، إن النظرة الموضوعية لهذا الاقتصاد تقتضي الاعتدال في التعامل مع هذا المال، فإذا كان الإنسان ينظر إليه وهو يعلم أنه لا غنى به عنه وأنه عصب الحياة، ولكنه ليس ملكا له ولن ينال منه أكثر من رزقه، فإنه سيحاول أن يجعله في يده وأن لا يجعله في قلبه، فمستقر المال في النظرة الإسلامية اليد، ومستقره في النظرات الأخرى القلب، ولهذا قال رسول الله (ص): «ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى من النفس»، فتجد الفقير الذي لا يملك دينارا ولا درهما غنيا مرتاحا راضيا بما أوتي ويتصرف على وفق ما آتاه الله، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا}، وتجد الغني في المال إذا كان المال في قلبه إذا فقد منه درهما واحدا ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وينشغل عن نفسه في غمرة تنمية ماله حتى يكون خادما للدنيا بعد أن كان المفروض أن تكون الدنيا خادمة له، فكثير من الناس هم عباد للدنيا يخدمونها والدنيا ليست خادمة لهم، إذا جعل الله تحت أيديهم بعض هذه الدنيا كان أذى عليهم ونكالا ووبالا، فهم يعملون لها ليل نهار، ويقيضون أوقاتهم الثمينة لخدمتها، وفي المقابل نجد آخرين لم يؤتهم منها إلا قليلا ولكنهم استغلوه لخدمة أنفسهم فقدموه لآخرتهم واستعانوا به واستعفوا به في دنياهم، وبذلك يسروه للتيسير الصحيح، وسيروه وفق ما أمر الله به، ومن هنا كان جوابهم يوم القيامة جوابا منجيا، وجواب الأولين جوابا مخزيا، فقد ثبت عن رسول الله (ص) أنه قال: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيم أبلاه وعن عمره فيم أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن علمه فيم عمل به» فالمال يسأل عنه سؤالين يوم القيامة، من أين اكتسبته وفيم أنفقته، من أين اكتسبته أولا هل أخذته من حله، ثم بعد ذلك فيم أنفقته، هل وضعته في محله، وهذان السؤالان لا بد أن يجعلهما الإنسان نصب عينه وهو يغدوا فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعلم أن الناس جميعا تجار، وأنهم جميعا مفطورون على حب المال، ولكن تفاوتهم في ذلك أن منهم من لا يأخذه إلا من حله ولا يضعه إلا في محله، ولا يطغى إذا تكاثر عليه ولا يجزع على ما فاته منه كما قال تعالى: { لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آَتَاكُمْ} فلا ينبغي للإنسان أن يحزن على ما فاته منه لأن ذلك سلبي ويجعله يتحسر ويتقطع حسرات على أمر غير مقدور ولا يمكن أن يناله، فيأخذ ذلك جزءا من وقته وتفكيره دون أن يفيده شيئا، وليس له كذلك أن يفرح بما نال منه لأن ذلك مدعاة للطغيان، ولهذا كان قوم قارون ناصحين حين قالوا له: {وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} فهذا قانون متكامل يشتمل على أربعة مواد ينبغي لكل ساع لجمع المال أن يجعلها نصب عينيه، أولا أن يبتغي فيما آتاه الله الدار الآخرة، ثانيا أن لا ينسى نصيبه من هذه الدنيا وحظه منها، ثالثا أن يحسن كما أحسن الله إليه، وأن يستشعر مسؤوليته عن الفقراء حين أغناه الله، رابعا المادة الرابعة ولا تبغ الفساد في الأرض، أن لا يبغي الفساد في الأرض وهذا إذا حاولنا شرحه فإنه سيستفيض بنا الحديث ولن نأتي إلا بحقائق يسيرة من معنى هذه الآية القليلة الألفاظ الكثيرة المعاني، فإن قوله: {وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآَخِرَةَ } لم يقل فيها: وابتغ بما آتاك الله الدار الآخرة، لأن ذلك مستوى إيماني رفيع جدا وهو أن يخرج الإنسان كل ما لديه في سبيل الله، وهذا لا يصل إليه إلا الصديقون، ولا يمكن أن يكون قانونا عاما لكل الناس، بل قال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، وفي للظرفية المقتضية للوسط، فالظرفية تقتضي الوسط، فليس مطالبا بأن ينفق خير ماله، وليس مطالبا كذلك بأن يتيمم أدناه: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} فيما آتاك الله الوسط، فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا يقتضي من الإنسان أيضا أن يعلم أن له نصيبا محصورا قليلا في هذه الدنيا، حتى لو عاش عمرا طويلا فإنه عندما يوضع في قبره لأول مرة ينسى ذلك العمر كله، ويظن أنه ما عاش فيها إلا يوما أو يومين، {إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا} ومن أجل هذا فإن على الإنسان أن يعرف حظه من هذه الدنيا وأن يعلم أنها ليست له وحده، وأن عليه أن يصلح ويدعها لمن وراءه، فهو بمثابة الراكب يستظل بظل الشجرة لا ينبغي أن يقطعها ولا أن يفسدها حين ينتهي غرضه منها، بل يتركها لمن يستظل وإذا رجع هو مرة أخرى استفاد منها، وهذا المثال النبوي عجيب جدا أيضا، فإن الرسول (ص) ضرب لنا المثل قال: «مالي ومال الدنيا؟ إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة» الراكب إذا رأى الشجر ينبغي أن يختار خيره وأبلغه ظلا وأنظفه مكانا لأنه يختار لنفسه المكان الملائم المناسب، ولكنه مع ذلك لا يتعب تعبا شديدا في استصلاح هذا الظل ولا الاستقرار فيه فهو يعلم أن الظل سيتحول، سريعا ما يتحول الظل وينقلب ويعود الفيء إلى المشرق، ثم تغرب الشمس وحينئذ يزول الظل، {ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا} هذا القبض اليسير العجيب، كذلك فإن الراكب إذا استظل بظل شجرة فكثيرا ما يجعلها ذلك ذات ظل دائم لمن يأتي بعده لأن العرب يقولون: ولن تصادف مرعى ممرعا أبدا** إلا وجدت به آثار منتجع فالمكان الذي يستظل الناس به عادة سيكون مطروقا ويستظل الناس به، وإذا رحلت عنه قافلة عادت إليه أخرى، وكذلك فإنه مما يستدل به الناس على معالم الأرض، وقد جاء في الحديث لعن من غير منار الأرض، والمقصود بذلك أن من يقطع الأشجار التي هي معالم في الأرض أو يغير الطرق والسبل يؤدي بعمله ذلك إلى إتلاف وإفساد في الأرض، فهو ملعون على لسان محمد (ص)، بعد هذا قال: {وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ} إن على الأغنياء أن يستشعروا أن الله عز وجل هو الذي قسم هذه الأرزاق، ولم يقسمها على أساس عقل ولا على أساس علم ولا على أساس جاه ولا على أساس قوة بدن، وإنما قسمها لحكمة وجعلها امتحانا ومسؤولية، فمن آتاه الله هذا المال فعليه مسؤولية عظيمة تجاه الفقراء، عليه أن يستشعر أنه أب لطائفة من الناس قد جعل الله أرزاقهم تحت يده، وولاه عليهم، واستخلفه على أرزاقهم، فهو سبيل من سبل الخير وطريق من طرقه، إما أن يستكثر وإما أن يستقل، ولهذا فإن الذين جعل الله أرزاق الناس تحت أيديهم إن أحسنوا نالوا أجور كل من انتفع بما تحت أيديهم من المال، وإن أساءوا فإنه سيكتب عليهم أوزار أولئك الذين منعوهم ما يستحقون وحالوا بينهم وبين ما خلق الله لهم، وهذا يبين أصلا شرعيا كبيرا ينبغي أن يدخل فيه كثير من القواعد، فمن أجله حرم الله الربا، ومن أجله حرم الله الاحتكار، ومن أجله حرم الله الإسراف، ومن أجله حرم الله الغش والخيانة، ومن أجله حرم الله سبحانه وتعالى الجهالة في البيع، ومن أجله حرم الله سبحانه وتعالى الإتلاف وكسر المسكوك وغير ذلك من أنواع الإفساد في الأرض، فهذه الأصول ما حرمت إلا من أجل المسؤولية التي هي على الأغنياء تجاه الفقراء، وإذا استشعروها فإنهم سيستصلحون المال لا لأنفسهم بل ليكونوا منفقين على عدد كبير من الناس، وليزداد التكافل بذلك بين الناس، ومن أجل هذا شرع الله سبحانه وتعالى الزكاة في المال وجعلها واجبة على الأغنياء تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وهي حق في المال نفسه، وشرع كذلك حقوقا أخرى في المال، ففي المال حق غير الزكاة كما صرح رسول الله (ص) بذلك، وذكر من تلك الحقوق أن يحتلب الإنسان من ضروع مواشيه إذا أوردها فوجد المحتاجين لذلك على المياه، وكذلك من هذه الحقوق النفقات من الزرع إذا بدا صلاحه كقوله تعالى: {وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} وآتوا حقه يوم حصاه، وهذا الحق الذي يجب يوم الحصاد قال أكثر المفسرين هو غير الزكاة الواجبة لأن الزكاة ليست واجبة في يوم الحصاد بعينه وإنما هو حق زائد عليها وهو صدق الشكر على ما أخرج الله لنا من الثمرات، كذلك فإن مشروعية الصدقات الأخرى والتكافل الاجتماعي المطلق الذي به يتم الاتصال بين البشرية وترتبط الوشائج بينها كالصداق بين الرجل والمرأة وكالنفقات الواجبة بين الوالد وولده والزوج وزوجته والمملوك ومالكه فهذه النفقات كلها تدخل في إطار هذا التكافل الاجتماعي الذي هو من المسؤولية المالية، وكذلك الحق العام في المال، فإن في المال حقا عاما للأمة كلها، يؤخذ إما بطريق التبرع وإما بطريق التقويم والتقدير، وقد أجمعت الأمة على أنه لا يحل أخذ الضرائب من الناس عن غير رضاهم وإنما يكون ذلك في حال الضرورة فقط، وأول ما عرفت هذه الأمة الضرائب كان في أيام المتقي العباسي في القرن الرابع الهجري في بدايته بسنة ثلاثمائة وعشر، وقد أنكر ذلك العلماء، وقد صرح القرافي رحمه الله بأن من قال بجواز الضرائب فقد كفر بالله العظيم، ويقصد بذلك أن الرسول (ص) بالغ في تحريم أخذ المال من غير طيبوبة النفس فقال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وهذا مقتض لأصل الحرمة، ولكن مع ذلك نص العز بن عبد السلام وغيره على أنه إذا احتاج بيت المال إلى ما يسد الحاجات العامة للناس فإنه ينظر إلى تلك الحاجة وتقوم وتقدر ثم لا يتجاوز بها قدرها، ويطلب الناس أن يتبرعوا، فإن تبرعوا بما يسد ذلك فبها ونعمت، وإن لم يتبرعوا بذلك أخذ منهم، ولكنه يبدأ بطبقة الأغنياء الكبار ثم الذين يلونهم حتى يكون ذلك بقسمة عادلة، ومن هنا فإن الضرائب إنما طورها الغربيون، وهم الذين فرضوها وجعلوها مصدرا من مصادر بيت المال، وبندا من بنود الميزانيات التي تقوم عليها الدول، فطريقتهم فيها تختلف عن طريقة بلدان العالم الثالث، فطريقة الغربيين في الضرائب أن الضرائب لا تدخل في الخزينة العامة، وإنما تدخل في صناديق مخصصة، فإذا أخذ من الناس ضريبة للطرق فإنها تجعل في صندوق مختص بترميم الطرق، ومن لم ترمم الطريق إلى بيته فإن القانون يحق له أن يمتنع عن دفع الضريبة حتى يرمم له الطريق إلى بيته، وكذلك الضرائب التي تؤخذ لبناء المدارس فلها صندوق متخصص، وكذلك الضرائب التي تؤخذ لبناء المستشفيات لها صندوق متخصص، وكذلك الضرائب التي تتخذ للمعاشات الاجتماعية ولما تدفعه البلديات للفقراء الذين يعيشون في إيالتها كل ذلك له صناديق متخصصة، أما في العالم الثالث فالضرائب تدفع للخزانة العامة للدولة، فتختلط بكل الأملاك، ومن هنا تكون دولة بين الأغنياء ويأخذها ذوو السلطان ولا ينتفع بها من سواهم، وتخرج عن هدفها الذي من أجله أخرجت ومن أجله وضعت، ومن هنا تكون كلا، فلا ترضى نفوس الناس بإخراجها لأنهم لا يرون شيئا أنجز بها، ويتحايلون عليها بأنواع التحايل فلا يستورد منها إلا جزء قليل ولذلك تقر الأنظمة القائمة في بلدان العالم الثالث بعجزها عجزا مطلقا عن جباية الضرائب المقررة، وذلك راجع لأمرين، أولا أن هذه الضرائب غير عادلة وغير موافقة لشرع الله، ثانيا أن هذه الضرائب كذلك غير مقنعة للناس فلم تصرف فيما يقنع الناس ويرضيهم، وإنما تصرف إلى جيوب أقوام لا يستحقونها، كذلك فإن من موارد التكافل الاجتماعي ومن أوجهه المطلوبة ما بينه الشارع في أن الأغنياء عليهم أن يشاركوا بأموالهم في إعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز دينه، وهذا يشمل إنفاقهم في الجهاد في سبيل الله وغزو العدو، وإنفاقهم كذلك في تعلم العلم وفروض الكفايات وإقامة الجسور والمساجد والمستشفيات وغير ذلك من أنواع المصالح التي يحتاج الناس إليها، وكانت في صدر الإسلام هذه الأمور تقام مشاريع فردية يقوم بها بعض الأفراد فيقيمون المدارس من تلقاء أنفسهم ويجعلونها أوقافا ويقفون عليها الحوانيت والمزارع، فيضمن ذلك بقاءها واستمرارها وحريتها، ومن أجل هذا أخرجت العلماء الفطاحلة الكبار لأنها عاشت في جو من الحرية يضمن لها الاستمرار وعدم التدخل في قراراتها، أما حين أخذت أوقاف المدارس وأصبحت مؤسسات تابعة للدول فإنها عاشت في أحضان العبودية وفقدت أنفاس الحرية، ومن أجل هذا لم تخرج العلماء وإنما أصبحت مؤسسة من مؤسسات النظام الفاسدة، لاحظوا أن الأزهر كان مؤسسة حرة ينفق عليه من الأوقاف التي وقفها عليه تجار المسلمين في قرون طويلة، وقد أخرج عددا كبيرا من العلماء واستفادت منه أمة محمد (ص) عبر القرون، ولكنه أممت أوقافه وأخذت لصالح الدولة وأصبح الأزهر ينفق عليه من ميزانية الدولة، وأصبحت الدولة هي التي تعين فيه وتعزل، وتضع له المناهج والبرامج فتوقف دوره وتوقف عطاؤه ولم يخرج ما كان يخرجه من العلماء، وكذلك في البلدان الأخرى المختلفة، ثم إن المستشفيات أيضا كان الأفراد والتجار يقومون ببنائها ويتطوعون بها لصالح الأمة ويوقفون عليها الأوقاف ذات الريع المستمر فتستفيد الأمة من ذلك وسار هذا زمانا طويلا في أمة محمد (ص)، وعاش الناس فيه بخير حتى حصل تأميمها ورجعت إلى مؤسسات مملوكة للقطاع العام ليس وراءها عناية ولا صيانة ولا يرصد لها مال متخصص، أو أصبحت أملاكا للقطاع الخاص هي مجال للتنافس وليست تسيرها روح الإنسانية والتكافل فأصبحت مكانا لكسب المال والتنافس في جمعه، ولم يعد فيها الدافع الأصلي التكافلي، وقد كان الناس قديما يجتهد أحدهم في أن يبني مسجدا وأن يقيم مدرسة وأن ينشئ مارستانا والمارستان هو المستشفى، وفي ذلك يقول أحد الشعراء يمدح أحد العلماء: أنشأت مدرسة ومارستانا** لتصحح الأديان والأبدانا فالمدرسة لتصحيح الأديان والمارستان لتصحيح الأبدان، وكذلك من أوجه هذا التكافل الديات التي تدفعها العواقل، فإن الخطأ ليس من كسب الإنسان وليس من طاقته التخلص منه، ولو حمل عليه لانتقص إنتاجه وقصرت به أفكاره عما ينتج لصالح هذه الأمة، فلو كان الإنسان إذا ساق سيارته فحصل حادث من غير قصد منه فمات به عدد من الناس كلف هو بدياتهم أجمعين لترك الناس سياقة السيارات وتوقف كثير من المشاريع النافعة، وكذلك لو أن الإنسان كان يعلم أنه إذا بنى مبنى فانهد في أثناء بنائه من غير قصد منه فإنه سيدفع ديات المتأثرين به لتوقف الناس عن البناء وتعطلت منافع كثيرة للبشرية، وكذلك في الحفر وكذلك في استخراج المعادن وكذلك في غيرها من أنواع المشاريع النافعة، فجعل الله تعالى تشجيعا للناس على هذا هذه العواقل التي تتولى الخطأ عن أصحابه، وتتحمل ديات الخطأ سواء كان ذلك في الأنفس أو في المنافع أو في العظام والشجاج، وكذلك الدواوين التي تقوم مقام العواقل فالحضارة منافية للقبلية التي هي نظام بدوي في الأصل، والحضارة تجتمع فيها القبائل وتتخالط فيها الأعراق وتخف فيها العصبية القبلية فمن أجل هذا احتيج فيها إلى بديل عن العواقل فأنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإجماع من الصحابة الدواوين التي أصبح أهل كل مهنة يدفعون فيها الدية تكافلا فيما بينهم، فالشرطة يدي بعضهم عن بعض والجيش يدي بعضهم عن بعض، والمعلمون يدي بعضهم عن بعض، والأطباء يدي بعضهم عن بعض، وهكذا، فهذا عندما يزول النظام القبلي وتختلط الحضارة وتنتفي العصبيات، إن هذه الأوجه للتكافل والتكامل بين البشرية ينبغي أن لا يغفل عنها وأن تدعم وتقوى في حياة البشرية حتى يعرف من أين يؤتى بهذا المال وفيم ينفق، ثم إن على الإنسان أن لا يسرف، ولهذا قال: {وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ}، فالفساد في الأرض يتناول الإسراف في النفقات لأن الإنسان له طاقة وله حاجة، فعليه أن يقارب بين حاجته وبين ما يستغله فما يحتاج إليه لا ينبغي أن يكون أكثر مما ينتجه، وإذا كان ينتج الكثير فإن عليه أن لا يزيد ذلك في احتياجاته وأن يرشد تلك الاحتياجات لأن من البشرية قوما لا ينتجون أصلا وهو يقوم عليهم بمقابل ذلك، ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه لا يحب المسرفين، ولذلك يقول محمد مولود بن أحمد فال رحمه الله تعالى: والسرفَ السرفَ إن السرفا** عنه نهى الله تعالى وكفى ولا يحب المسرفين كاف** في كف كفك عن الإسراف وقد اختلف العلماء في الإسراف هل يدخل في أعمال البر أو لا، وأجمعوا أنه يدخل في أمور الدنيا كلها، فذهبت طائفة منهم إلى أن السرف يدخل حتى في أعمال البر، فالذي يتصدق بكل ماله إذا كان يعلم حاجته إليه ولم يكن له تدبير يعوض به هو مسرف، واستدلوا على هذا بأن رسول الله (ص) حين بلغه أن ثابت بن قيس بن شماس جذ نخله فتصدق بثمرته كلها ولم يستبق منها تمرة واحدة يفطر عليها، غضب رسول الله (ص) غضبا شديدا في ذلك، فهذا دليل على أن الإسراف في مثل هذه الأمور غير محمود شرعا، فعلى الإنسان أن يترك ما ينفق به على أهله، وقد ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه مرض بمكة فأتاه رسول الله (ص) يعوده فقال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا بنية لي، أفأتصدق بمالي كله في سبيل الله، قال: لا أمسك عليك بعض مالك، فقال: أفأتصدق بثلثيه؟ قال: لا، فقال: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، قال: أفأتصدق بثلثه؟ قال: نعم والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك يوشك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام وينضر بك آخرون، فقلت يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي؟ فقال: نعم، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فِي امرأتك، فعاش سعد بعد هذا زمانا وورثه اثنا عشر ولدا لصلبه، وخرج من ثلث ماله في سبيل الله عدة مرات بعد ذلك، وهذا يقتضي منا أن لا نتعجل في نظرنا وأن يكون نظرنا متزنا، فالإنسان آتاه الله تعالى ثلث ماله يمكن أن يوصي به حتى في حال مرضه مرض الموت، «إن الله قد أعطاكم ثلث مالكم عن دبر منكم تتصدقون به» وهذا هو الوصية، والوصية لا تزيد عن الثلث، فلا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، ثم إن السرف يتناول كذلك السرف المضر وهو السرف في المطاعم والمشارب ونحوها مما يقتضي مضرة بالبدن، وهذه المضرة أنواع، فما من شيء فيه منفعة إلا وفيه نوع آخر من أنواع الضرر، فالماء فيه منافع لا تحصى، ومع ذلك فيه مضار، فإنه يقتضي نقصا لبعض إفرازات المعدة التي يحتاج إليها الإنسان في هضم غذائه، وكذلك غيره من أنواع الذواق وأنواع ما يستعمله الإنسان في نفسه، فإذا زاد عن الحاجة أو تمحض وحده أضر، ومن هنا فإن كثيرا من الأمراض المعروفة اليوم سببها في الغذاء، كالمرض السكري فهو ناشئ عن الإسراف في النشويات، وكمرض القلب فهو ناشئ عن الإسراف في الدهنيات، وكمرض الكلى فهو ناشئ كذلك عن الإسراف في المآكل ونقص المشارب، وكذلك أنواع الأمراض الأخرى كبعض الأمراض الجلدية فهي ناشئة عن الإسراف في استعمال السكر مثل البرص والبهق وغيرها، وكذلك بعض الأمراض تنشأ عن الإسراف في استعمال الأملاح، وبعضها ينشأ عن الإسراف في استعمال السوائل وهكذا، ومنها الترهل وهو السمنة الزائدة فإنها تنشأ من استعمال السوائل والإسراف فيها أكثر من الحاجة، فإنها تقتضي الاتساع في البطن، وذلك يقتضي الإرهاف في المآكل، فإذا أكثر الإنسان وأسرف فيها تضخم بدنه فكان ذلك مرضا من الأمراض لأنه يضعف قواه ويؤدي إلى احتكاك مفاصله وتوقف أماكن النمو في بدنه وكثيرا ما يؤدي إلى أمراض كثيرة، وكذلك الحركات فالإسراف فيها يقتضي بعض الأمراض، فالإسراف في الرياضات يقتضي المرض في الغضروف الذي يحول بين فقرات الظهر فيتمطط ويتمدد وكذلك يقتضي الإسراف في المشي أمراضا في الركب كالاحتكاك والاحتقان وغيره، فالإسراف مضرة أيا كان هذا الإسراف، وكذلك الإسراف في الملابس فإنه يقتضي أيضا مضرة، فزيادة ثقلها ثقل على الإنسان ووزن زائد على وزنه، والإنسان ذو طاقة محددة عليه أن لا يزيد وزنه عليها وأن لا تزيد حمولته الدائمة عليها، ومن هنا فإن كثيرا من الأمراض ينشأ عن عدم الاعتدال في النعلين، النعل إذا حصل احتكاك فيه فإن الإنسان سيسير غير مستقيم إحدى رجليه أرفع من الأخرى، فيصاب بمرض ونقص للتوازن بسبب ذلك لأن سرعة الدم في أحد الشقين ستكون أبلغ من سرعته في الشق الآخر، فيؤدي هذا كثيرا إلى بعض السرطانات وبالأخص السرطان في الدم وغيره، ومن هنا فإن إحدى الشركات التي كانت تصنع النعال في الولايات المتحدة الأمريكية أقيمت عليها دعوى في المحاكم بسبب أن نعالها لم تكن مبالغا في وزنها من ناحية المقاس فرفعت عليها دعوى وأدى هذا إلى إفلاسها وأخذ أموالها، فإذن هذا يقتضي منا عدم الإسراف مطلقا، ويذكر العلماء أن الإسراف في القراءة أيضا مقتض لأمراض بدنية ولزيادة في القوة العقلية، والقوة العقلية وغيرها من القوى وزنها الله على حسب بدن الإنسان وعلى حسب روحه، فإذا زادت اختل توازنه، كثير من الناس يريد زيادة العقل ويتمنى ذلك، لكنه لا يعلم أنه لو زيد عقله لاقتضى ذلك اختلالا فيه، لأن الله وزنه على هذا الميزان وقدره على هذا التقدير، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى} فهذا التقدير العجيب تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى وهو الاعتدال العجيب في خلقة الإنسان، فلا بد أن يكون الذراعان على حجم واحد واليدان على حجم واحد والأذنان كذلك والعينان كذلك والرجلان والساقان والفخذان وهكذا حتى يتم قوام الإنسان وما شذ عن هذا كان عيبا في الخلقة ونقصا فيها وضعفا في الخلقة البشرية. |
| الأربعاء, 08 ديسمبر 2010 15:18 |
آخر تحديث للموقع: الجمعة, 14 فبراير 2025 13:52