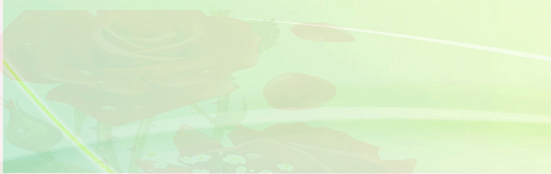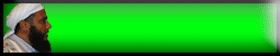| الوسطية في الإسلام |
|
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده خير الدين وأرسل به أفضل الرسل وأنزل به خير الكتب وارتضاه للناس وقال فيه: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا}، وقد نزلت هذه الآية على رسول الله (ص) يوم الجمعة العاشر من شهر ذي الحجة وهو واقف بعرفة بعد أن صلى الظهرين جمعا وقصرا ووقف بالموقف، وكان ذلك في العام العاشر من الهجرة، ولم يعش النبي (ص) بعد نزولها إلا اثنين وثمانين يوما، وقد بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أنزلت هذه الآية، فقيل له ما يبكيك؟ فقال: لم يتم شيء إلا نقص، وقد صح عنه رضي الله عنه أن حبرا من اليهود أتاه فقال: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا معاشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقال عمر: أما إنها أنزلت يوم الجمعة ورسول الله (ص) واقف بعرفة، إن هذه الآية قد حددت أن الدين المرضي عند الله هو ما جاء به محمد (ص)، وأنه لا يمكن أن يزداد بعد رسول الله (ص) ولا أن ينقص منه، ولذلك قال مالك رحمه الله: قد أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ وقت نزولها دينا فلا يكون اليوم دينا، من هنا فكل ما يزيده الناس وكل ما ينقصونه من الدين فإنما هو إما إفراط وإما تفريط، فالإفراط هو بالزيادة في الدين لما ليس منه، والتفريط هو بالنقص منه والتقصير عما طلب فيه، وكلا الأمرين مقيت شرعا والتوسط بينهما هو العدل الذي به قامت السموات والأرض، وهو الذي أنزل الله به الوحي على رسوله (ص) وهو الذي ارتضى من عباده، فكل ما شرعه الله لعباده فهو المصلحة المتوسطة التي تراعي أمور الدنيا وأمور الآخرة وتراعي حقوق الأفراد وتراعي حقوق الجماعات وتراعي حقوق الرب جل وعلا وحقوق العبد وهذه الأمور لا يمكن أن يراعيها مشرع إلا العليم الخبير اللطيف الذي يعلم السر وأخفى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، من هنا فلا يمكن أن يأتي أحد بأعدل مما شرعه الله لعباده، ولا يمكن أن يأتي بما هو مصلحة إلا ما شرع الله لعباده، فكل ما شرعه الله لعباده فهو مصلحتهم، لكن قد يغيب عن الإنسان وجه المصلحة فيه لأنه لا يخطر بباله ما يتعلق بالآخرة، فيظن أن المصلحة مقصورة على أمور الدنيا فقط، ولذلك فمصائب المؤمنين وبلاياهم هي عين المصلحة عند الله، وذلك أنها تكفر من سيئاتهم وترفع من درجاتهم، وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وتلهمهم اللجاء إليه وتذكرهم به سبحانه وتعالى، فإن الغنى مدعاة للطغيان ومدعاة للنسيان فإذا لم يمرض الإنسان ولم يشتك من أية شكوى لم يتذكر حاجته إلى الباري سبحانه وتعالى، ولم يحسن الضراعة إليه والدعاء هو العبادة، وكذلك فإن المصالح الأخروية لا يمكن أن تدرك بمقتضى العقول الدنيوية لأن الإنسان إنما ينطلق من المعايير المادية التي يمكن أن تقاس بها أمور الدنيا ولا يمكن أن تقاس بها أمور الآخرة فالوزن باعتبار الدنيا إنما هو بالثقل، والوزن في الآخرة إنما هو بما عند الله، ولذلك رجحت قلامة قدر الظفر فيها لا إله إلا الله على السجلات التي قد سدت الأفق فشالت السجلات، فلذلك الوزن يومئذ الحق، فالوزن الدنيوي هو وزن مادي يراعى فيه الظواهر فقط، والوزن يومئذ أي في يوم القيامة هو الحق الذي لا يمكن أن يلتبس بغيره ولا أن يخالطه باطل بوجه من الوجوه، إذا عرفنا هذا أدركنا أن كل ما شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى فهو عين المصلحة لنا وإن خفي علينا ذلك، وأن علينا أن نرضى بكل ما شرعه الباري سبحانه وتعالى بكل استسلام وطمأنينة وأن نعلم أنه سبحانه وتعالى غني عنا وعما يصيبنا وعما يعطينا، فهو الغني الحميد لا يصل إليه نفع ولا ضر من عباده، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، وقد بين سبحانه وتعالى أن الخلائق جميعا لو كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ومن هنا يعلم أن العبادة إنما هي لمصلحة العابد لا لمصلحة المعبود، وأن المنتفع بها هو العابد وحده، وأن الله قادر على هداية الناس أجمعين وإلهامهم طريق الحق وأطرهم عليه أطرا، ولكنه يبلوهم بالخير والشر ويمتحنهم بذلك، ولهذا قال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذي لا يعقلون، قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، الأيام التي خلت فأخذ الله فيها السابقين أخذا وبيلا، يعيدها الله سبحانه وتعالى ويكررها لأن من سنته التي هي مصلحة أهل الأرض بقاء الصراع الأبدي فيها بين الحق والباطل، ومن هنا فلو توقف هذا الصراع لحظة واحدة فخلص الحق على الأرض واستقام الناس أو خلص الباطل على الأرض وكفر الناس لم يكن لهذه الدنيا معنى ولا فائدة، فالدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل، فلذلك امتحننا الله بهذه الحياة الدنيا، ولهذا قال رسول الله (ص): وإن الله مستخفلكم فيها فينظر كيف تعملون، فهذه الدنيا دار استخلاف وامتحان يمتحننا الله سبحانه وتعالى فيها فلو تمحض فيها الحق لنجح الناس جميعا واستحقوا الخروج من هذه الدنيا التي هي دار الأكدار إلى دار القرار، ولو كفروا جميعا لرسبوا في الامتحان وحل عليهم غضب الله الأكبر: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فاحتيج إذن إلى أن يبقى على هذه الأرض صراع مستمر بين الحق والباطل، وهذا الصراع لا بد فيه من مروق وخروج على صراط الله ومنهجه، وهذا المروق والخروج منه ما يسير عن يمين صراط الله ومنه ما يسير عن يساره، فما كان عن يمين الصراط فهو غلو وتجاوز للحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى وابتداع في الدين، وما كان عن شماله فهو تقصير في الدين ونقص منه، وكلا الأمرين مذموم، وهذا الصراط الدنيوي الذي تركنا عليه رسول الله (ص)، وهو المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك هو تمثيل للصراط الأخروي الذي هو جسر منصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليب كشوك السعدان يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوا، ومنهم من يزحف على مقعدته، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم، وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي، فيمكن أن يقوم الإنسان نفسه الآن في طريقه، فإن كان سالكا لهذا الطريق لا يميل ذات اليمين ولا ذات الشمال مع بنيات الطريق ويلتزم ما جاء به رسول الله (ص) من عند الله تعالى رجا أن يثبت على ذلك لأن الله تعالى يقول: {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء}، وإن كان يميل ذات اليمين أوذات الشمال مع بنيات الطريق فليخف على نفسه يوم القيامة عندما يرتجف الصراط أن يميل عنه يمينا وشمالا نسأل الله السلامة والثبات، ودعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، ورسول الله (ص) على مرقبة من الصراط يقول: اللهم سلم سلم، فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على نجاته في سلوكه لهذا المهنج الرباني وهذا الصراط المستقيم، حتى يقيس بذلك نجاته على الصراط الأخروي يوم القيامة، ونحن نعلم أن الصراط الأخروي مزلة مدحضة، كما وصفه رسول الله (ص)، وهذا الصراط الدنيوي كذلك صعب جدا، وبالأخص في أيامنا هذه أيام الفتن التي هي كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، فلا بد لذلك أن يحرص الإنسان كل الحرص على أن لا يضع قدمه إلا في مكان معتدل في سواء الطريق، وأن يعلم أن على حافتي الطريق أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه يا عبد الله إلي إلي، وفوق السورين داع الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه، ثم إن علينا أن نعلم أن الاعتدال على هذا الصراط منهج متكامل يكمل بعضه بعضا، ويصدقه، فلا يمكن أن يكون الإنسان معتدلا في اعتقاده على الصراط المستقيم ومائلا في عمله، لأن عقيدته تدعوه إلى العمل، إذا استقامت عقيدته دعته إلى الاستقامة على العمل، ولا يمكن أن يكون مستقيما في عبادته غير مستقيم في معاملته لأن العبادة تدعو إلى حسن المعاملة، ولا يمكن أن يستقيم في تعامله مع الله وينحرف في تعامله مع المخلوقين، لأن الاستقامة مع الله سبحانه وتعالى تقتضي لين الجانب لعباده والاستقامة في الخلق، ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤديا لحقوق الأقربين مقصرا في حقوق الأبعدين، فيكون على الصراط المستقيم لأن أداء حقوق الأقربين مقتض منه للزيادة في أداء حقوق الآخرين حتى لا يكون مطففا، ومن هنا فهذا المنهج الرباني متكامل يكمل بعضه بعضا، وإذا حصل الميل في جانب من جوانبه أدى ذلك إلى اختلال البنيان كله، ألا ترون أن حجرا واحدا في أساس البنيان إذا كان مائلا فبنيت عليه الأسوار الطويلة والمباني الشاهقة كان ذلك سببا لتزحزح تلك المباني الطويلة ولا يقل أحد هذا الحجر مساحته يسيرة صغيرة والبناء طويل جدا، لعلمه أن ذلك البناء الطويل مبني على ذلك الحجر الواحد فإذا مال ذهب البنيان كله، من هنا على الإنسان أن يحرص على الاعتدال في كل هذه الأمور على المنهج المستقيم، وأن يحرص على الانطلاق من هذا المنهج في كل صغيرة وكبيرة، وهو بالاستسلام لحكم رسول الله (ص)، فلا بد أن نرضى جميعا بكل ما جاء عن رسول الله (ص) سواء تعلق بالعقائد أو بالعبادات أو بالمعاملات أو بالأخلاق أو بأمور الدنيا لا بد أن نستسلم لأن ما جاء به النبي (ص) هو الصراط، وأن من زاد فيه أو نقص منه فإنما خرج عن ذلك الصراط وضل ضلالا بعيدا، وسوف يستمر في غوايته لأن الله سبحانه وتعالى بين أن من ضل عن بداية الطريق لا بد أن يفتن بأنواع الفتن التي تقصيه ولا يزال في ابتعاد عن المحجة بعد ذلك، قال الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون}، فلا بد إذن من الحرص على هذا الصراط المعتدل المستقيم، والغريب في الشأن أن هذا الصراط هو أيسر السبل، وأقومها، وأن كثيرا من الناس لا يصبرون على الاستقامة فهم يملون العافية، نسأل الله الاستقامة والثبات، يملون العافية ومن هنا فيريدون الزيادة أو النقص من دين الله كحال أهل سبأ الذين أنعم الله عليهم بأنواع النعم في الأرض والأمن واستقامة الحرث وغير ذلك فملوا هذا و{قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق}، فلا بد إذن أن لا نمل العافية وأن نحرص على الاستقامة على هذا الدين وعلى وسطه وسوائه، ثم علينا أن نتعلم أن الميل ذات اليمين أو ذات الشمال في أي جانب من جوانبه مقتض لأن يستمر ذلك في الجوانب الأخرى من حيث لا يشعر الإنسان، فمثلا في الجانب العقدي إذا أخذ الإنسان بسواء الطريق أدى ذلك منه لاستقامة عمله كله ولأن ينطلق من المبدإ الصحيح فلا يكون غاليا مجاوزا للحد في الاعتقاد، فذلك مدعاة لمسلسل من الأخطاء لا حصر له، إذا بالغ الإنسان في اتباع ما تشابه من القرآن أو في اتباع ما تشابه من السنة وغلا في ذلك لا بد أن يصل إلى حد يكون به مبتدعا آت بما لم يأت عن رسول الله (ص) ويأت بما لم يقله أحد من قبله، ومن هنا يزداد ضلالا بعيدا، ولا يزال في ذلك الطريق المظلم الموحش نسأل الله الثبات والاستقامة، وهذا الذي يؤدي بالناس إلى تكفير المسلمين ويؤدي بهم إلى الغلو في الدين بأن يأخذوا جزئية واحدة ليست من المحكم البين فيجعلوها محكا للناس ومعيارا لهم يمتحنونهم على أساسها، فليس ذلك من المنهج الذي كان عليه رسول الله (ص)، وإنما كان يأخذ الناس بمحكم الدين، وبالأسهل والأخف، وعندما سأله جبريل عن الإيمان ذكر ستة أمور فقط، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وعندما أتاه رجل وقد حضر الصف فقال: يا رسول الله أسلم وأقاتل أم أقاتل ثم أسلم، قال: أسلم ثم قاتل، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وقاتل فقتل، فقال رسول الله (ص): عمل هذا قليلا وأجر كثيرا، ولم يكن رسول الله (ص) من المتكلفين، لذلك لا تجدون في أي حديث ولا في أية آية مناظرة على الطريقة المنطقية، أو على الطريقة الفلسفية مع أي حبر من أحبار أهل الكتاب أو عالم من علماء ذلك الزمان، أو فيلسوف من فلاسفتهم، بل عندما جاء نصارى نجران إلى النبي (ص) أنزل الله عليه الكتاب المحكم البين فيهم من سورة آل عمران حين قال: {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون}، وعرض عليهم رسول الله (ص) المباهلة التي أمره الله بها، وكذلك في مجادلته للمشركين إنما كان يقرأ عليهم القرآن، فعندما أتاه عتبة بن ربيعة وهو ابن عمه وكان شيخا كبيرا محترما في قريش وأراد أن يجادله وذكر له حجج المشركين التي أوحى إليهم الشياطين {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم}، فاستمع إليه رسول الله (ص) بكل أدب حتى أكمل ما معه من الحجج، فقال له : اسمع أبا الوليد، فقرأ رسول الله (ص): {بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون}، حتى قرأ عليه صدر هذه السورة فهذه مجادلة رسول الله (ص)، وهذا الذي يقنع الناس، فما يظنه الناس سببا للهداية أو سببا للإقناع من النظر الفلسفي والمنطقي وتركيب الأشكال والجدل وغير ذلك إن أدى إلى إقناع شخص فليكن ذلك الشخص واحدا في المليون، وقد أسلم الملايين المملينة في أنحاء الأرض مشارقها ومغاربها من غير مجادلات فلسفية ولا تركيب أشكال منطقية، وقرئ عليهم هذا القرآن فمن هداه الله منهم رأى أنه عين الصواب واستسلم له، ولذلك فإن رجلا من أحبار اليهود من أهل اليمن كان في ديره يتعبد ذات ليلة فمر راكب من حوله يقرأ سورة النساء فاستمع إليه الراهب حتى بلغ قول الله تعالى: {يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها}، فلما سمع هذه الآية نزل مسرعا من الدير وأقبل إلى المدينة مؤمنا وهو يلمس وجهه يخاف أن يطمس على قفاه، قبل أن يقبل الله إسلامه، وهكذا فإن أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير حين قدما المدينة وذهبا إلى بني عبد الأشهل وجاءهما أسيد بن حضير يريد طردهما من المدينة وقد أرسله بذلك سعد بن معاذ أقبلا إليه فرحبا به وأدنيا مجلسه ثم قالا: هل لك في أن نعرض عليك بعض ما جئنا به من هذا الكتاب الذي أنزل على صاحبنا أي على رسول الله (ص)، فإن كان حقا عندك قبلته وإلا خرجنا وتركنا لك مكانك، فقال: قد أنصفتما فجلس إليهما فقرآ عليه من القرآن، فبادر إلى الإيمان ولم يخالف في كلمة واحدة مما قرآ عليه، ومثل هذا ما حصل لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عندما أرسل المشركون عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى النجاشي بالهدايا وهم يريدون إخراج المهاجرين من الحبشة وأتيا التجار الكبار والملأ من أهل الحبشة فزينوا لهما إخراج المهاجرين، وقالوا: هؤلاء يزعمون أن عيسى عبد مملوك، وأولئك يعبدون عيسى من دون الله ويزعمونه ابنا لله، فشق ذلك على المهاجرين، فلما دعاهم الملك للمناظرة وجمع حوله الملأ من قومه، قام عمرو بن العاص فتكلم فقال: إن هؤلاء يزعمون أن عيسى عبد مملوك، فتقدم جعفر بن أبي طالب فبين لهم عقيدة المسلمين في عيسى وقرأ الآيات التي أنزلها الله في ذلك: {إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون}، وبين أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فأخذ النجاشي عودا فقال: والذي يحلف به النجاشي لم يزد عيسى على هذا شيئا، قدر هذا العود، فاقتنع النجاشي بذلك وأسلم، وحسن إسلامه، ورجع وفد المشركين بما جاءوا به، كذلك في المقابل أيضا إذا حصل التقصير في جانب الاعتقاد والنقص فيه أدى ذلك أيضا إلى التفريط في كثير من الأمور التي عليها ينبني أمر هذا الدين، فلا بد أن نعلم أن التفريط في هذا الجانب أيضا مقتض لأن يقبل غير المسلم في المسلمين، وأن يتغاضى عن الكفر الصريح، وأن يتغاضى عن التعدي على حدود الله، وأن يتغاضى عن الابتداع البين الذي هو هدم للدين، وأن يترك ركن من أركان الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يترك ما أخذ الله علينا العهد به من القيام بالقسط والعدل في الأرض وهذا ما أكده الله في كتابه فقد قال: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله}، وقد قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط}، ومن هنا فالذين يريدون التنازل والمحاباة والمسامحة لا بد أن يصلوا إلى خروج ومروق عن الجادة بالكلية، فهذا الدين دين فرقان يميز بين الحق والباطل، ولا يمكن أبدا أن يلبس فيه الحق بالباطل، فلبس الحق بالباطل هو الفتنة بعينها، وقد قال الربيع بن أبي الحقيق: «إنا إذا مالت دواعي الهوى** وأنصت السامع للقائل** واصطرع القوم بألبابهم** نقضي بحكم عادل فاصل** لا نجعل الباطل حقا ولا** نلط دون الحق بالباطل** نخاف أن تسفه أحلامنا** فنخمل الدهر مع الخامل» فلذلك لا يمكن أن يصل الإنسان في محاباة الناس إلى حد التجاوز فقد عرض على رسول الله (ص) أقل من ذلك فلم يقبل، وعندما عرض عليه المشركون أن يسكت عن سب آلهتهم لم يفعل في البداية حتى أنزل عليه في ذلك الأمر المؤقت فقط، {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم}، وعندما عرضوا عليه أن يعبد آلهتهم ويعبدوا إلهه أنزل الله تعالى: {قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين}، فعرفوا أنها الفاصلة، لا يمكن أن يقع بعدها أي ميل أو ركون، وقد قال الله تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتسمكم النار}، وقال تعالى: {وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا}، ثم إن رسول الله (ص) ربى أصحابه على هذا المنهج، فهذا سعد بن أبي وقاص تضغط عليه أمه وهي أحب الناس إليه وأمنهم عليه وتضرب عن الطعام، فلما كادت تموت، أتاها سعد فهمس في أذنها وقال: يا أماه، لو كان لك مائة نفس فخرجت نفسا تلو على أخرى على أن أرجع عن شيء من ديني ما رجعت فاحيي أو فموتي، فلذلك لا بد أن نعلم أن مسلسل التراجع والمسامحة سيصل بالناس إلى ما يعرف اليوم بالإنترفيت أي الدين العالمي، وهو دين مشوه يجمع كل الأديان وكل الأيديولوجيات، وقد بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية، وأراد به أصحابه أن يجعمعوا أولا الديانات الثلاث السماوية، أن يأخذوا الأمور المتفق عليها بين المسلمين واليهود والنصارى فيجعلون من ذلك دينا موحدا، وهذا ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى وهو غاية في التغيير والتبديل ولا يمكن أن يستقيم بحال من الأحوال ولا أن يقره المسلمون ولا أن يرضوا به، وقد حاول المستعمرون من قبل كثيرا من هذا النوع من الطعن في الدين، ومن محاولة التراجع عنه فلم يستجب لهم المسلمون والذين يستجيبون لمثل هذه الدعايات لا بد أن يتركهم التاريخ على الأثر، فلذلك لا حرج في أن ندعو المبتدعة إلى ترك ما هم عليه من بدعهم بتقريبهم إلى الصراط المستقيم لكن من المستحيل أن نحاول تقريب الصراط المستقيم إليهم ومزحزحته عن مكانه، فهذا في جانب الاعتقاد، أما في جانب العبادة فمن المعلوم كذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطى للمخلوق حقوقا، فلعينه حق ولزوره حق ولأهله حق ولعمله الدنيوي حق ولغرمائه حق ولذريته حق ولجيرانه حق ولدعوته حق، وهذه الحقوق لا بد من أدائها، فمن أداء حق الله الحرص على أداء كل حق رتبه الله، والذين يتغافلون عن هذا أو ينسونه إنما يجعلون العباد ندا لله، فيظنون أن تلك الحقوق هي ند لحق الله، وهذا غاية في الانحراف لأن تلك الحقوق ما رتبت إلا بترتيب الله، فمن حق الله عليك أن تنام عند حاجة بدنك إلى النوم، ومن حق الله عليك أن تأكل عند حاجة بدنك إلى الأكل، ومن حق الله عليك أن تشرب عند حاجة بدنك إلى الشرب، ولذلك أنكر رسول الله (ص) الإنكار البالغ على الرجل الذي كان قائما في الشمس لا يستظل وبين أن هذا من الغلو الشديد وأن من رغب عن سنته فليس منه، وأنكر كذلك على الثلاثة الذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء فغضب رسول الله (ص) حتى عرف الغضب في وجهه وقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، ونهى الذين أرادوا التبتل ومنهم عثمان بن مظعون رضي الله عنه، نهاهم عن ذلك أشد النهي وزجرهم عنه، ونهى أيضا الحولاء بنت تويت وكانت امرأة من بني تيم بن مرة كان ينفق عليها أبو بكر فكانت تقوم الليل كله لا تنام، وكانت تصوم الدهر كله، فجاءت تزور عائشة رضي الله عنها، فدخل رسول الله (ص) فقال: من هذه؟ فقالت: فلانة تذكر من صلاتها وصيامها أي تثني عليها عائشة، فقال رسول الله (ص) مه: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من الأعمال ما لا تطيقون معناه اجتهدوا أن تؤدوا من الأعمال الصالحة ما تطيقون فقط ولا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيق، وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص حين كان شابا قويا فكان يصوم النهار دائما ويقوم أكثر الليل نهاه عن ذلك فقال: إن لعينك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه، وأمره أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فقال: إني أستطيع أكثر من ذلك، فأمره أن يصوم يومين من الأسبوع الاثنين والخميس فقال إني أستطيع أكثر من ذلك، فأمره أن يصوم صيام داود أن يصوم يوما ويفطر يوما فلما كبر عبد الله وضعف جسمه قال: ليتني أخذت برخصة رسول الله (ص)، وكذلك فإنه (ص) بين لأمهات المؤمنين عندما اعتكفن فرأى الأخبية كثرت في المسجد خطر أن يكون ذلك لغير الله، فقال: آلبر ترون بهن؟ عندما دخل في اليوم العشرين من رمضان وهو يريد أن يدخل معتكفه رأى الأخبية في المسجد فقال: ما هذا؟ فقيل: أمهات المؤمنين يعتكفن، فقال: آلبر ترون بهن؟ فلذلك لا بد أن يعرف الإنسان أن الاجتهاد الزائد في أداء حق الله في مقابل تعطيل حقوق الآدميين، ليس من الاستقامة على المنهج الصحيح ولا هو من سلوك سواء الطريق، وقد صح عنه (ص) أنه رأى رجلا من الأنصار يلزم المسجد فسأل من يقوم عليه، فقيل: أخوه، فذكر أن أخاه أفضل منه، أخوه الذي يعمل ويجاهد ويجمع المال من حله وينفق على أخيه هذا أفضل منه، وهذا يقتضي أن المؤمن المعتدل المتكسب الذي ينفق على من تلزمه نفقته أفضل من الذي ينقطع للعبادة فيكون كلا على الآخرين وعيالا عليهم، من هنا نعلم أن الإنسان إذا أراد المبالغة في العبادة وتجاوز الحد فحينئذ لا يمكن أن يشاد الدين إلا غلبه، فسيغلبه الدين، ولا بد أن يأتي وقت يضعف فيه أمام بدنه أو أمام عقله أو أمام نفسه أو أمام شهوته أو أمام المرض الذي يصيبه، ولا بد كذلك أن يصاب بإحباط من كثرة ما يحصل، ولذلك حصل لبعض الذين دخلوا من هذا الباب وبالغوا فيه أنه كان يظن أن مقامه عال جدا، فلما حضره الموت ندم غاية الندم وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب، فالذي يريد المبالغة في العبادة وتجاوز الحد فيها لا بد أن يبتلى بأحد أمور، إما أن يحتقر المنهج المستقيم فيريد أن يزيد على ما كان عليه رسول الله (ص) وأصحابه وهذا غاية الضلال البعيد، ولذلك قال ابن مسعود: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد (ص) فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا، وقاعدة أهل السنة والجماعة: لو كان خيرا لسبقونا إليه، وهي عكس قاعدة المشركين، المشركون يقولون: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وأهل السنة يقولون: لو كان خيرا لسبقونا إليه، كل خير قطعا فهو في ما جاء به رسول الله (ص) وما عمل به وعمل به أصحابه رضوان الله عليهم، ولا يمكن أن يأتي الآخر بأفضل مما جاءوا به، ولهذا قال مالك رحمه الله: إن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها، أو أن يبتلى كذلك بأمر آخر وهو الابتداع بحيث يشرع ما لم يأذن به الله، فيظن أن الدين ناقص وأنه هو يكمله من عنده، وهذا شريك الأول في الضلال المبين لأنه زعم أن الله تعالى لا يعلم ما يتمم به دينه ويكمله، فجاء هو ليكمله باجتهاده من عنده، وقد ذكر الشاطبي رحمه الله أن أعظم ما في البدع من المنكر أن صاحبها يظن أنه يكمل الدين، وأن الدين كان ناقصا قبل اجتهاده هو، وأنه جاء بجديد يكمل به الدين الذي جاء به محمد (ص) فهو يزعم أن قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم غير صحيح، نسأل الله السلامة والعافية، أو أن يبتلى كذلك بالغرور، بأن يبالغ في العبادة فيظن نفسه وصل إلى مقام عال وقد يخيل إليه الشيطان أنه حطت عنه التكاليف، وأن له أن يقع في المناكر والمعاصي، ويظن بذلك أنه وصل إلى مقام لا يتضرر بالمعصية كما زعم اليهود الذين قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فهذا الحال هو من سلوك طريقهم، وقد بين النبي (ص) أنه لا بد أن يكون في هذه الأمة من يسلك طريقهم، فقال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذن، فاليهود الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات اتبع آثارهم غلاة الناس في العبادة من هذه الأمة الذين يزعمون أنهم وصلوا إلى مقام لا يعذبهم الله فيه، بل يصل بعضهم إلى الجسارة على الله فيقول: لو أن الله رماني في النار لانطفأت، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا غاية في الانحراف والبعد عن الطريق المستقيم، وعن هذه المحجة، بل ربما ابتلي بأمر آخر وهو أن يزعم أنه وصل إلى مقام يتحد فيه العابد بالمعبود، وهو الذي يسمونه بوحدة الوجود، أو بمقام الحلول، أو بوحدة الوحدة، أو بالاتحاد، أو بوحدة الشهود، وكلها اصطلاحات ترجع إلى هذه الفكرة من أصلها وإن كانت بينها فروق دقيقة، فيزعمون أن الإنسان حينئذ إذا عرف أتاه اليقين، ويتأولون قوله تعالى: {واعبد ربك حتى يأتيك اليقين} بهذا، وهذا غاية في الغلط وسوء الفهم، فاليقين الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي حتى يأتيك الموت، والذين يزعمون هنا أن يأتيهم اليقين أي مقام معلوم يصلون إليه قد انحرفوا غاية الانحراف وضلوا سواء السبيل وقادهم الشيطان بأزمتهم إلى الكفر البواح نسأل الله السلامة والعافية، وربما ابتلي المبالغ في العبادة أيضا بأمر آخر وهو بالازدراء، فيسول له الشيطان أن كل عمله غير مقبول عند الله، وبالتالي فأداؤه للعمل وتركه له سواء، ومن هنا فسيترك العمل من هذا الوجه بل ربما ابتلي بالوسوسة في الإخلاص، فيظن كل عمل غير خالص فلا يزال يعيد الصلاة ويعيد الوضوء كما ترون الموسوسين الذين إذا غسل أحدهم وجهه لم يكد ينتهي منه، والمبالغين في العبادات يصابون بأنواع من البلاء الذين يتجاوزون الحد المشروع يصابون بكثير من أنواع البلاء من هذا القبيل، وفي المقابل المقصرون أصحاب التفريط في العبادة، هم الذين ابتلوا بالميل ذات الشمال عن هذا الصراط، فنسوا الحكمة التي من أجلها خلقوا، ونسوا أنهم ما خلقوا إلا لعبادة الله، ففرطوا في عبادته وقصروا فيها، وتمنوا على الله الأماني وتعلقوا بالظنون، ولذلك فإن الشيطان يستهويهم إلى الوقوع في معاصي الله ولا يذكرهم إلا بآيات الوعد وأحاديث الوعد وينسون آيات الوعيد، أولئك يتركون في البداية المندوبات، ثم يتركون السنن ثم يوصلهم ذلك إلى ترك بعض الواجبات، ثم يوصلهم ذلك إلى ترك الأركان ثم يوصلهم ذلك إلى سوء الخاتمة عند الموت نسأل الله السلامة والعافية، فكل تقصير وترك للعبادة فهو مدعاة لأن يأخذ الإنسان نقصا وتقصيرا من المقام الذي فوق ذلك الذي انتقص منه، إذا قصر الإنسان في رواتب الصلاة فلا بد أن تقع في الصلاة خدوش، ما يشكوه الناس من جمود الدموع إذا قرئ القرآن لا يبكون، وهو لو قرئ على الجبال لتفجر منها الماء، لو قرئ على الجبال لبكت، {لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون} سببه التقصير في العبادة، وما يشكوه الناس من عدم الخشوع في الصلاة سببه التقصير في النوافل، وأنتم تعرفون أن كثيرا من الناس يطمئنون في الفريضة ما لا يطمئنون في النافلة، إذا أراد أحدهم أن يصلي النافلة نقرها نقرا ولم يبال بها حتى في الاستقبال وحتى في الالتفات وحتى في عدم تسوية الظهر في الركوع وغير ذلك، وإذا أراد أن يؤدي الفريضة حاول إتقانها، لكن لا يمكن أن يتقن الفريضة ما دامت نافلته هكذا، فالنفل هو سياج الفرض وكل خدش فيه سيصل إلى الفرض، ولذلك مثل العلماء للنافلة وبالأخص الرواتب في الصلوات بأنها كلحاء العود، وإذا انتزع اللحاء يبس العود، اللحاء القشر إذا انتزع يبس العود، والذين يقصرون في عبادة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكونوا من أوليائه، لأن أولياءه هم الذين يأنسون به سبحانه وتعالى، فلا يحزنون عندما يحزن الناس إذا جاءت المصائب عرفوا أنها من عند الله وأنها كانت مكتوبة قبل أن تكون فرضوا بما قدره الله، وإذا جاء الرخاء والسراء لم يغتروا بذلك لعلمهم أن ذلك كان مكتوبا وله أجل مسمى، {ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم}، والذين يقصرون في هذه العبادة لا يمكن أن يتذوقوا طعم الخدمة الخاصة للجبار سبحانه وتعالى، ولا أن يستشعروا نعمة الانتساب إليه سبحانه وتعالى، فلذلك لا بد أن يوجد فيهم من الجفاء وغلظ الطبع وسوء المعاملة وسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله ومع شرعه الشيء الكثير، فهم لا يحترمون القرآن ولا يقدرون السنة ولا يحترمون شعائر الله ولا يعظمونها، {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب}، ولذلك لا يبحون الناس الحب في الله، إذا رأوا من يعبد الله سبحانه وتعالى ويحبه ويقدره ويدعو إليه لا يحبونه لا يجدون في نفوسهم حبا له، لأن الجانب العاطفي في التعامل مع الله لديهم قد انخرم، وبذلك لا يعرفون الحب في الله، فالحب في الله إنما يكون من الاستقامة على المنهج ولزوم عبادته، فإذا عرفت أنت أنك قاصر عن أداء حق الله الذي يستحقه من العبادة أحببت جبريل وميكائيل لأنهما يعبدان الله العبادة التي يستحق، وأحببت كل عابد لله لأنه يؤدي الحق الذي تحب أنت أن تؤديه وأنت عاجز عنه، وكذلك فإن الذين يقصرون في العبادة يصابون بأمراض أخرى من أعظمها الجسارة على المعصية، فإن العابد لله سبحانه وتعالى تنهاه عبادته عن المعصية، قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، والذي لا يجد هذا السور بينه وبين المعصية كان مع المعصية في لحاف واحد يجد نفسه معها في كل أحيانه، بينما من كان في العبادة بينه وبين المعصية سور عظيم، ومن هنا فجوارحه لا تنقاد إلى المعصية حتى لو استزله الشيطان إليها لا يمكن أن يستمر كما قال تعالى: {إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون}، كذلك فإن التقصير في العبادة مقتض من الإنسان أن لا تكون همته عالية وأن يرضى بأقل المنازل، فمن كانت همته عالية أراد أن يزداد كل يوم بل كل ساعة قربا إلى الله، وأن يكون من المنافسين في الدرجات العلى من الجنة، وأن يكون من الذين تتجافى جنوبهم عن مضاجعهم عند النوم يتذكرون السباق، وأن الله سبحانه وتعالى قد فتح المسابقة الآن لعباده، فمن لم يخذله الله كان من المتسابقين إليه بالطاعات في هذا الوقت الذي فتحت فيه أبواب العبادة، وأذن فيه الملك الديان في المناجاة للمناجين له، ولم يغلق بينه وبينهم بابا، ولا أسدل دونهم حجابا، ولا خفض أودية ولا رفع شعابا، فهم يتسابقون في التقرب إليه، {أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا}، {إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين}، والذي يقصر في العبادة في أوقاته إذا جاء وقت الشدة لم يكن من الذين تستجاب دعواتهم في ذلك الوقت لأنه لم يتعرف إلى الله في الرخاء، (تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة)، والذين يقصرون في العبادة لا يكونون أئمة ولا سادة للمؤمنين، والله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى الدعاء بهذا الدعاء: {والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما}، فلا بد إذن من لزوم المنهج الوسطي الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط في جانب التعبد، فيعلم الإنسان أن خير العبادة عبادة محمد (ص)، وأن تلك العبادة متنوعة بتنوع الحال، وأنها مترتبة على الأوقات والأزمنة، فما كان رسول الله (ص) يقوله في الصباح حاول أن تقوله في الصباح وما كان يقوله في المساء حاول أن تقوله في المساء، وما كان يفعله في وقت النوم إذا أوى إلى فراشه حاول أن تفعله، وما كان يفعله في قيام الليل حاول أن تفعله، وما كان يفعله من الرواتب وما كان يفعله في الحضر والسفر من العبادات حاول أن تؤديه، وبذلك تكون قد لزمت سواء الطريق لا تجد ما يتعب بدنك ولا ما يتعب عقلك، ولا ما يتعب روحك، ولا تكون أيضا مقصرا بل تكون من المزدادين في القرب الذين يسيرون سيرا وئيدا يؤدي إلى المقصود دون استعجال وبكل تأن وتؤدة، وهذا ما يحبه الله ورسوله (ص) كما قال رسول الله (ص) لأشج عبد القيس: (إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة)، فإذا كان الإنسان متأنيا في عبادته يؤديها بصدق وإخلاص وبحضور بال ويكلف منها ما يستطيع وما يطيق، ولم يكن من الذين يريدون حرق المسافات وقطع الطريق في أسرع الأوقات الذين لا يبقون ظهرا ولا يقطعون مسافة، فإنه بذلك سيصل إن شاء الله تعالى إلى المقام المرضي عند الله ولا يزال في زيادة وترق طيلة حياته، فإذا عجز عن شيء كتب له كاملا كما كان يفعله في صحته، كما بين ذلك رسول الله (ص)، يقول الله تعالى لملائكته إذا مرض العبد أو سافر: انظروا ما كان يفعله عبدي في صحته وحضره فاكتبوه له، فالله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تملوا، وهو غني عنا وعن عبادتنا، ولا يمكن أن نتقرب إليه بما لم يشرع لنا، فالذي يمكن أن تضره ويمكن أن تنفعه يمكن أن تتقرب إليه بنفع لم يأمرك به، ويمكن أن ترفع عنه ضررا لم يأمرك برفعه، لكن الذي لا يمكن أن تنفعه ولا أن تضره لا يمكن أن تتقرب إليه إلا بما شرع لك وبين، ولا يمكن أن تتجاوز ذلك بحال من الأحوال، كذلك في جانب المعاملة لا بد أن نعلم أن أكثر ما يفرق القلوب في المعاملات هو ما يتعلق بالمال، فجمع المال لا بد فيه من التوسط، لا إفراط ولا تفريط، فالذين يفرطون في جمعه وينفقون أوقاتهم في جمعه سيفقدون أوقاتا ثمينة وفرصا نادرة للعبادات، والذي يظل طيلة يومه مشتغلا بالصفق في الأسواق ستفوته أوقات الإجابة، سيفوته وقت النزول، سينام عن الأوقات التي يحصل فيها السباق بين العابدين المتسابقين إلى الله، {وفي ذلك فليتنافس المتنافسون}، سيفوته الصف الأول في كثير من الأحيان، سيفوته الرباط، (سبق المفردون)، سيفوته كثير من الخيرات، والذي يبالغ في جمع المال وجمع حطام هذه الدنيا والاشتغال بها يصاب بعدد من البلايا أولا أن تكبر هذه الدنيا في نفسه فتكون أكبر مبتغاه وتكون غاية علمه، ويشتغل بها قلبه فيمتلئ بها قلبه ولو كانت يده صفرا منها، فالمشغولون بالدنيا ليسوا بالضرورة أغنياء، فكثير من الأغنياء الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم، وكثير من الفقراء الدنيا ليست في أيديهم بل هي في قلوبهم، فلذلك المحذور شرعا هو تعلق القلب بها، وأن يجعلها الإنسان أكبر همه ومبلغ علمه، وأن يكون عابدا لها خدمته وسعيه من أجلها، فهذا الخطر الماحق، وهي ضرر عظيم بصاحبها لأنها تؤدي به إلى حد التجاوز والطغيان، وقد قال الله تعالى: {إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى}، وقال تعالى: {ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء}، فالبغي والطغيان وتجاوز الحد إنما يحصل بالمبالغة في جمع الدنيا، وفي المقابل لا بد أيضا من أن نعرف أن التقصير في جمعها هو قصور من الإنسان، فالذي ينصرف عنها بالكلية ولا يريد أن يدبر شيئا من أمور الدنيا ولا أن يكتسب شيئا خارج عن المنهج الصحيح لم يسلك طريق رسول الله (ص)، فالرسول (ص) أخذ بالأسباب وأعملها ولم يتركها، ولو كان الزهد في الدنيا المحمود شرعا مقتضيا لترك الأسباب والانقطاع للعبادة والرهبانية لعمله رسول الله (ص) وأصحابه، فلما لم يعملوه ووجدنا منهم التجار ووجدنا منهم الأغنياء ووجدنا منهم المنفقين في سبيل الله، ووجدنا أوقاف رسول الله (ص) ينفق منها على الآلاف من الأرامل واليتامى، ووجدنا أنه ادخر قوت سنة لأهل بيته ووجدنا أنه (ص) أفاء الله عليه أرض بني النضير فادخر بعضها لعياله ووجدنا أنه (ص) كان يغرس النخل بيده بأبي هو وأمي وكان يجذب الماء بأبي هو وأمي (ص)، وساعد في غراس نخل سلمان الذي كاتبه عليه أولياؤه، ورأيناه يذهب إلى الأسواق ويشتري ويمشي فيها، وهذا ما استنكره عليه المشركون، وأقره الله عليه في كتابه، ورأينا أصحابه وهم أفضل أهل الأرض بشهادة رسول الله (ص) لهم منهم التجار كأبي بكر رضي الله عنه الذي ينفق على عياله من ريع تجارته، وكان رأس ماله أربعمائة درهم، فكان يبيع بها في البز أي الملابس والزيت، فما ربح أنفقه على الذين ينفق عليهم، وكان عيال أبي بكر كثيرا من الأسر الفقيرة، ووجدنا منهم كذلك عبد الرحمن بن عوف وكان تاجر الله في هذه الأرض، بارك الله له في صفقاته، فهو ينفق على كثير من اليتامى والمساكين، وقد أوصى بثلث ماله لبقية أهل بدر فكان غناهم جميعا، ووجدنا منهم الزبير بن العوام الذين كانت استثماراته في الأراضي الشاسعة والمزارع الكبيرة، وقد ترك مالا كثيرا كان ثمنه الذي قسم بين زوجاته غنى لهن، ومنهم أبو طلحة الأنصاري الذي كان له من المزارع الشيء الكثير، وكان يملك بير حاء وهي أحسن مزرعة في المدينة، وكان يصلي تحت كل نخلة ركعتين، ووجدنا منهم سعد بن عبادة بن دليم وكان من كبار التجار والأغنياء الذين إذا رجعوا من صلاة الضحى ذهبوا إلى مزارعهم، وإذا ارتفع النهار ذهبوا إلى تجاراتهم، فإذا حان وقت الزوال اشتغلوا بالصلاة والتهيئة للفريضة، فإذا رجعوا منها قاموا بحق أهليهم، وهم يوزعون أوقاتهم هذا التوزيع ولا يفوتهم شيء من الخير، إذا عرفنا ذلك عرفنا أن المنهج المعتدل يقتضي عدم الإفراط وعدم التفريط، فالذي يظن أن الزهد في الدنيا المحمود شرعا يقتضي منه أن لا يشتغل بجمع الدنيا كاذب مخالف للمنهج الصحيح وإنما سلك طريق اليهود والنصارى الذين ابتدعوا رهبانية من عند أنفسهم، والذي يظن أن الله لا يرتضي لعباده جمع الدنيا من حلها كاذب لأن الله تعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا وقال: {فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه}، وجعلنا خلفاء في الأرض، قال: {إني جاعل في الأرض خليفة}، وأمرنا بإصلاحها وعدم إفسادها بعد إصلاحها، فكل هذا يقتضي منا أن نعمل وأن نصلح في هذه الأرض، لكن مع ذلك لا بد أن نعلم أن الإصلاح فيها وأن جمعها لا يقتضي أن تكون في القلوب بل تكون في الأيدي على وفق المنهج السابق، والذين يفرطون في جانب جمع المال يصابون ببلايا من أعظمها العبودية للمخلوق، فإن الإنسان مفطور على الحاجة، الإنسان نفسيه الفقر {يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد}، ومن هنا فإذا كان الإنسان عازفا عن مزاولة الدنيا بالكلية، لا يعمل أي عمل يدر عليه نفقته فهو عبد لغيره، فالذي ينفق عليه له عليه كل الضغوط، لأنه يخافه ويحبه ويمكن أن يطيعه في كثير من المواقف، ولذلك لا بد في تحقيق العبودية لله من الاستغناء عن المخلوقين، أن يجد الإنسان نفسه ليس عليه لأحد أي ضغط، فلا خوف ولا طمع يصده عن قول الحق وعن العبودية لله سبحانه وتعالى، وبذلك يستطيع الإنسان التحرر من الأغيار وما لم يفعل ذلك الإنسان فهو تبع لغيره ومن عيال الغير، محتاج لمن يقوم على شؤونه في كل أوقاته، كذلك مما يبتلى به المفرط في أمور الدنيا أنه كثيرا ما تتعلق نفسه بها وقلبه بها، فيبتلى بمحبتها من حيث لا يشعر وإن كان يتصنع في الظاهر ويبدي للناس أنه لا يحبها لكن قلبه مائل إليها، ومن هنا نشهد اليوم أهل الكنيسة وهم يتظاهرون بالانقطاع عن الدنيا وهم أشد الناس ولوغا فيها، بل لا تكاد مدة يسيرة تنصرم إلا وفضائحهم تعلن في الإعلام، وقد كانوا في الصدر الأول كذلك يجمعون الأموال ويكنزونها قبل بعثة رسول الله (ص)، وقد بين النبي (ص) قصصا من ذلك، والمنقطعون فيما يبدو للناس كثيرا ما يأتيهم الشيطان من قبل الشبهات ومن قبل الشهوات، وكثيرا ما يصابون بضعف في العقل يقتضي من الشيطان أن يستضعفهم، فيوسوس لهم الوساوس فيتخيل لأحدهم المرائي في يقظته فيرى أنه رأى كذا يقظة لا مناما وهي أحلام ورؤى وهي أضعف من مرائي النوم، مرائي اليقظة التي تحصل للإنسان إذا جاع أو مرض أو أجهد نفسه بالرياضات يرى في اليقظة مثل ما يرى في المنام، كالذي يصاب بحمى الملاريا في حال يقظته يهذي كأنه يحلم، وهو يقظان غير نائم، فكذلك الذي أجهد نفسه في العبادات ولم يسلك الطريق السوي الذي جاء به النبي (ص) يصاب بالهذيان فيرى أحلاما في اليقظة فيخيل إليه أنها صدق وأن فلانا أتاه، وأنه رأى النبي (ص) أو جبريل أو اللوح المحفوظ أو غير ذلك وكلها أحلام اليقظة عندما ضعف ضعفا شديدا خيل إليه الشيطان ذلك، وقد يكون بعضها من المرائي لكنها أضعف درجة من رؤيا النوم، فرؤيا النوم أقوى منها، لأنه حينئذ هو في جسمه وعقله أقوى منه عند استضعافه في حال اليقظة، كذلك فإن الذي يبالغ في الانقطاع عن الدنيا كثيرا ما يصاب بالتفريط في حقوق الآخرين، فهو مفرط في حقوق بدنه من الرعاية الصحية والنظافة، ومفرط في رعاية أهله ومفرط في أداء ديونه وقضاء حقوقه، كل هذه الأمور يفرط فيها والشيطان يغره بأن الذي عليه هو الصواب، وهو كلما ازداد به العمر ازداد بعدا عن المحجة والصراط المستقيم، كذلك جانب آخر من هذه الجوانب يتعلق بالمال وهو صرفه، هذا الدين فيه دين وسط بين الإفراط والتفريط، وقد قال الله تعالى: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما}، فالذين يسرفون هم المفرطون الذين يبالغون في إنفاق المال، فيضعونه في غير محله الشرعي كأنه ملك لهم يتصرفون فيه حيث شاءوا وكيف شاءوا، والواقع أنه أمانة عندهم من الله سبحانه وتعالى استخلفهم فيها لينظر كيف يعملون، ولهذا أدب الله رسوله (ص) أحسن الأدب على هذا المنهج القويم، فقال: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط} فلا بد أن يكون الإنسان متوسطا في الصرف وأن لا يكون مسرفا وأن لا يكون أيضا مقصرا فالحد الوسط هو المنهج الصحيح، وهو الاعتدال في هذا الباب، الذين يفرطون في جانب الإنفاق يسرفون فيبالغون في الإنفاق سواء كان ذلك في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة، فيتجاوزون الحد المرضي شرعا، ففي أمور الآخرة ينفقون أكثر مما حدده الشارع ويريدون بذلك المبالغة فيرجعون إلى الحد الذي ذكرناه في الإفراط في العبادة، ولذلك فإن رسول الله (ص) لما سمع أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أنفق جذاذ نخله جميعا في يوم واحد غضب عليه غضبا شديدا، وعندما سمع أن رجلا من الأنصار كان عليه دين قد دبر ستة أعبد عند موته توفي جمعهم رسول الله (ص) ورد هذا التصرف وأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، جعل له الثلث فقط، وكثيرا ما يرد بعض التصرفات في هذا الجانب إذا كان فيها غلو ومبالغة، قال لكعب بن مالك عندما عرض عليه في توبته وقد تاب الله عليه قال له رسول الله (ص) يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، فقلت: يا رسول الله أمن عند الله أم من عندك؟ قال: بل من عند الله، فقلت: يا رسول الله إن من تمام توبتي أن أخرج من مالي كله في سبيل الله، فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، وكذلك عندما جاء يعود سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع وهو مريض قال: قلت له يا رسول الله: إني ذو مال ولا يرثني إلا بنية لي أفأتصدق بمالي كله في سبيل الله، قال: لا، قلت: أفأتصدق بثلثيه قال: لا، قلت أفأتصدق بثلثه قال: فالثلث والثلث كثير، وفي رواية كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فقلت: يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي، قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك، وعسى الله أن ينفع بك أقواما ويضر بك آخرين، فكان سعد آخر العشرة موتا، وورثه اثنا عشر ولدا لصلبه من أولاده، فإن رسول الله (ص) لم يقبل من أولئك المبالغة في الإنفاق، وفي المقابل قد يقبل من بعض الناس ذلك لعلمه بقوة إيمانه واستقامته على المنهج كأبي بكر وقد خرج من ماله كله في سبيل الله، وقبل ذلك منه رسول الله (ص) لما جعل الله في قلبه من الإيمان والقناعة، ولأنه مكتسب عارف بأمور التجارات أيضا، وبأنه قطعا سيؤدي حقوق عياله ولا يمكن أن يظلمهم حقا لهم، فلذلك قبل منه رسول الله (ص) ذلك، أما من سواه فكان رسول الله (ص) يرد عليهم ولا يقبل منهم هذا النوع من المبالغات، وكذلك فإن الذي يبالغ في الصرف فيما يتعلق بأمور الدنيا لا بد أن يكون من المبذرين وهم إخوان الشياطين، وهذا النسب من شر الأنساب، فمن شر الأنساب أن يكون الإنسان أخا للشياطين نسأل الله السلامة والعافية، فهي علاقة سيئة وقد بين الله سبحانه وتعالى ضرر التبذير وأثره العظيم، وبين أنه سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين، ولذلك قال العلامة محمد مولود بن أحمد فال رحمه الله: «والسرف السرف إن السرفا** عنه نهى الله تعالى وكفى** ولا يحب المسرفين كافي** في كف كفك عن الإسراف» فيكفي في كف كفك عن الإسراف أن الله لا يحب المسرفين، ولا يحب المسرفين كافي** في كف كفك عن الإسراف، فالسرف في أمور الدنيا يقتضي من الإنسان كذلك أن تكون أكبر همه ومبلغ علمه وأن يحبها حبا شديدا فهو يتتبع موضاتها ويشتغل بها غاية الاشتغال، وبذلك كلما ازداد حطبها ازداد لهبها، ويزداد الإنسان ولوعا بها وتعلق قلب بها حتى يؤثرها على الآخرة نسأل الله السلامة والعافية، وقد قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وقال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كذلك في المقابل التقصير في مجال الإنفاق مقتض من الإنسان للبخل وأن يكون بخيلا لا يؤدي الحقوق التي عليه فالذي يمنع رفده ويأكل وحده ويضرب عبده شر الناس كما قال رسول الله (ص): (شر الناس من منع رفده وأكل وحده وضرب عبده)، هذا شر الناس عند الله عز وجل، من منع رفده معناه منع الماعون، لم يعط خيره للآخرين فلم ينفعهم مما آتاه الله، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ننفق مما آتانا، فقال: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وهذا يشمل الإنفاق على النفس والأهل والجيران، والإنفاق في أمور الدنيا والإنفاق أيضا في أمور الدين، وتركه هو من التقصير، والتقتير وهما مذمومان شرعا، فالمقترون مقصرون عن أداء الحقوق، وهم متصفون بصفة البخل التي هي شر الصفات، والذي يتصف بها الذي يصاب بالشح لا بد أن يبتلى نسأل الله السلامة والعافية بنقص الإيمان وتراجعه دائما، ولذلك قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فالشحيح لا يفلح أبدا، الشحيح البخيل لا يفلح أبدا، فلذلك لا بد من التوسط في هذا المنهج بين المبالغة في الإنفاق وبين التقتير والتقصير، كذلك في جانب الخلق، من الأمور المهمة أن يعرف الإنسان أن المنهج المستقيم هو هذا الدين الوسطي الذي يقتضي من الإنسان تحسين الخلق للناس بأن لا يكون إمعة تابعا كل أموره يقضيها غيره، وأن لا يكون أيضا مستكبرا جواظا لا يطيع في صغيرة ولا كبيرة، فالحد الوسط يقتضي من الإنسان أن يكون إيجابيا غير سلبي كما قال الشاعر: «لعمرك ما إن أبو مالك** بواه ولا بضعيف قواه** ولا بألد له لوثة** يعايي أخاه إذا ما نهاه، إذا سسته سست مطواعة، ومهما وكلت إليه كفاه، وكما قال الآخر: «إذا القوم أموا بيته فهو عامد** لأحسن ما ظنوا به فهو فاعله** يسرك مظلوما ويرضيك ظالما** فكل الذي حملته فهو حامله** فتى قد قد السيف لا متضائل** ولا رهل لباته وبآدله» فهذا يقتضي من الإنسان تمام الشخصية وأن لا يكون إمعة مقلدا في كل الأمر بحيث يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وبأن لا يكون أيضا جافيا يتقيه الناس مخافة شره، فقد جاء عن النبي (ص) أنه قال: شر الناس من تركه الناس اتقاء شره، من تركه الناس أو من حذره الناس اتقاء شره هو شر الناس، فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على الاستقامة في الخلق، أن لا يكون من الذين ينقادون لكل شيء فيقبلون البدع ويقبلون المنكر ويسكتون بمشاهدة المنكرات، ويظنون أن ذلك من الخلق والحياء، فهذا غلط بل هو من الإفراط في الحياء حتى يتجاوز الإنسان الحد، أنت ولو كنت صغيرا ولو كنت ضعيفا أنت مكلف من عند الله وجندي من جنود الله، ومن هنا فلا بد أن تحرس الثغر الذي تتولاه، وأن لا يؤتى الإسلام من قبلك، فلهذا لا بد أن تكون يقظا، وأن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر كبيرا كنت أو صغيرا، غنيا كنت أو فقيرا عالما أو جاهلا، لا بد أن تقوم بالحق الذي عليك لله وأن ترعى الدين فيما يليك وأن لا يدخل من هذا الثغر الذي أنت قائم عليه، فأنت حرسي في الخدمة، ولا يغترك الشيطان بدعوى الحياء، فإن الحياء الذي يمنع من تغيير المنكر أو الأمر بالمعروف أو السؤال عن أمر من الدين هو الحياء الذميم المقيت شرعا كما قال العلامة محمد مولود رحمه الله: «أما الحيا الذميم فالمانع من** تغيير منكر أو السؤال عن** أمر من الدين ونحو ذلك** وهو الذي عد من المهالك» ولذلك فإن أم سليم رضي الله عنها عندما سألت رسول الله (ص) عن المرأة إذا احتلمت فرأت ما يراه الرجل، هل عليها من غسل، قالت: إن الله لا يستحيي من الحق، وافتتحت كلامها بذلك، فلا بد أن يعلم الإنسان أن الاستحياء من الحق ذميم وليس من الخلق الطيب الحميد، وأن يعلم أن محاباة الناس والسير معهم فيما هم فيه وحضور مجالسهم ولو كان فيها ما لا يرضي الله والإغضاء عن ذلك ليس هو من الخلق الحميد، بل الخلق الحميد يقتضي من الإنسان أن يصبر على أذى الناس فيما يتعلق بشخصه هو، لكن لا بد أن يغضب لغضب الله إذا انتهكت حرمات الله، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما انتصر رسول الله (ص) لنفسه قط، وما غضب لنفسه إنما كان يغضب لغضب الله إذا انتهكت حرمات الله، فهذا الذي يغضب فيه المؤمن، يغضب إذا انتهكت حرمات الله، أما حقوقه هو فيغضي عنها ويسامح فيها، لكن حقوق الله لا يقبل فيها ذلك، ومن هنا فالمبالغة في تحسين الخلق ولينه حتى يكون الإنسان لا يستطيع أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر ولا قولا للحق،ولا وقوفا بموقف صوابا ويقتضي الخجل من قول الحق ويقتضي الخجل من إنكار المنكر كل هذا هو من الإفراط المذموم الذي لا خير فيه، وفي المقابل أيضا التفريط في الخلق بأن يكون الإنسان جافيا فظا غليظا في كل الأمر حتى في أمر الله إذا أمر بمعروف أتى بفظاظة وغلظة، وإذا نهى عن منكر أتى بفظاظة وغلظة، وكأنه ملك على رقاب العباد، فهذا النوع ليس مرضيا عند الله أيضا بل هو من التفريط في الخلق، فلا بد أن يكون الإنسان متأدبا بالخلق الذي اختاره الله لرسوله (ص): {فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاروهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله}، إن التفريط في الخلق يقتضي من الإنسان أن يسوء أدبه مع والديه وهما أمن الناس عليه وأن يسوء أدبه مع جيرانه المسلمين ولهم حقان حق الجوار وحق الإسلام، وأن يسوء أدبه مع كبار السن من المسلمين، وقد أوجب النبي (ص) توقيرهم فقال: (لن تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها)، ويقتضي سوء الأدب كذلك مع الملائكة الذين يشهدون على انتهاره للصغير، واعتدائه على الحقوق، ويقتضي سوء الأدب مع الملك الديان سبحانه وتعالى فلا بد أن يتذكر الإنسان قدرة الله عليه، فهذا أبو مسعود البدري رضي الله عنه قال: (كنت أجلد غلاما لي في الطريق، فإذا صوت من ورائي يقول:اعلم أبا مسعود، فنظرت فإذا هو رسول الله (ص) يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، قال: قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، قال: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار)، فلذلك التفريط في الخلق يقتضي من الإنسان أن يكون كالبهائم التي لا خير فيها فقدت العقل فهي سادرة على وجوهها لا تبالي نسأل الله السلامة والعافية، فلا بد أن يحسن الإنسان خلقه وأن يهذب نفسه وأن يزكيها وأن يكون ذلك بالمنهج الصحيح وعلى وفق الخلق النبوي، إن كثيرا من الناس اليوم في جانب الخلق يجمعون بين الإفراط والتفريط، ففي جانب الإفراط لا يستطيعون إنكار المنكر ولا تغييره ويزعمون أن ذلك للحياء، وفي جانب التفريط لا يجالسون بعض الكبار كأصهارهم مثلا ولا يواكلونهم ويظنون أن ذلك من الحياء والخلق وهذا إفراط والأول تفريط، فكلا الأمرين مقيت شرعا، فلو كان هذا من توقير الكبار لفعله رسول الله (ص) وأصحابه، وكان رسول الله (ص) يواكل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان، وهم جميعا أصهاره، وكان يجالسهم في بيوتهم، وأتى عليا وفاطمة وهما في فراشهما فقال: مكانكما حين أرادا القيام إليه، فجلس بينهما فجعل ظهره في بطن فاطمة ورجليه في بطن علي، قال علي فأحسست برد رجليه في ظهري، فهذا من أدب رسول الله (ص) ومن خلقه، ولا يمكن أن يرغب مؤمن عن خلق رسول الله (ص)، أو يظن أن خلقا أحسن من خلقه أبدا بحال من الأحوال لأن الله تعالى يقول: {وإنك لعلى خلق عظيم}، فلا يمكن أن نأتي نحن بخلق من عند أنفسنا ويكون أعظم من خلق النبي (ص) أو أحسن هذا من المستحيل، فلذلك هذا الذي يفعل مثل هذا النوع جمع بين الخستين جمع بين الإفراط والتفريط، وهذا منتشر كثير، وقد علمت أن بعض البيئات عندنا هنا من المؤسف أن الرجل فيها لا يصلي مع صهره في مسجد واحد، ولا يستطيع أن يليه في الصف، وهذا من الإفراط في الخلق، والمبالغة فيه، وهي غير مشروعة ولا لها وجه من الناحية الشرعية أبدا، بوجه من الوجوه، ولا يعوده إذا مرض ويقاطعه مقاطعة كاملة، والله تعالى يقول: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة}، أين المودة والرحمة إذا كان الإنسان مقاطعا لأهل زوجته لا يشرب عندهم ولا يأكل ولا يعود لهم مريضا ولا يسلم عليهم ويقاطعهم بالكلية، فإذن هذا ليس من الخلق المحمود شرعا بل هو من الإفراط المقيت في الخلق، إن علينا أن نعلم أن هذا الدين الذي ارتضاه الله لنا متدخل في كل شؤون حياتنا، وأن المنهج المستقيم فيه مانع للتطرف، والتطرف يشمل الأمرين يشمل الإفراط والتفريط فكلاهما طرف، التطرف مشتق من الطرف، «فكلا طرفي قصد الأمور ذميم»، الإفراط والتفريط كلاهما تطرف مقيت شرعا، واليوم يشتهر على ألسنة الإعلام إطلاق التطرف على جانب الإفراط فقط، وذلك أن الذين يطلقونه أهل الإعلام كلهم من المفرطين، فلذلك هم جميعا متطرفون، هم جميعا من المتطرفين لكنهم يريدون نقل التطرف إلى الجانب الآخر فقط، فالواقع أن طرفي المنهج كلاهما تطرف، إن الذي يعرف هذا المنهج المرضي عند الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه ملة رسول الله (ص) لا يمكن أن يرغب بنفسه عنها، فالله تعالى يقول: {ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه}، فلذلك لا بد أن ننزل هذا المنهج إلى أعمالنا كلها وأن نعرض عليه صغريات أمورنا وحياتنا وواقعنا، فمن هذه الأمور التي ينبغي أن تعرض على هذا المنهج الوسطي المستقيم ما يتعلق بمعاملة النساء وخلطتهن، فهذا الجانب المنهج المستقيم فيه أن المرأة أخت الرجل، وأن بينهما من التعاون على البر والتقوى ما شرع لهما، وأن كل واحد منهما مكلف حرم الله عليه أشياء وأوجب عليه أشياء، وحد له حدودا لا يمكن تعديها، وأن كل واحد منهما مسؤول عن رعاية هذا الدين ونصرته، وأن الإفراط بتجاوز هذا المنهج مقيت وأن التفريط بالتقصير دونه مقيت شرعا، والناس في هذا الباب في خلطة النساء يجمعون بين الأمرين، بين الإفراط والتفريط، ففي مجال الإفراط نجد بعض الناس يزدري النساء ولا يحترمهن كبشر ولا يقدرهن هذا التقدير، ولا يشاور ولا يستفتي في أمور الدين النساء ولو كن أعلم وأعقل منه، مع أن الله أمرهن بتعليم الناس فقال: {واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة}، وإذا أفتته امرأة فتوى لم يثق بها، فهذا إنما هو إفراط لا خير فيه وتفريط في حق المرأة نفسها، ومثل ذلك في المقابل الإفراط بتجاوز الحد في ما يتعلق بالتعامل معهن كالاختلاط المحرم والخلوة المحرمة، وكلام الريبة والخضوع بالقول، وكل ذلك مما حرم الله وهو من الحدود الخارجة عن المنهج السوي المستقيم، ونجد أيضا بعض الناس في هذا المجال في التعامل مع النساء يفرط ويبالغ فلا يظن أنه عليه أن يرد السلام على المرأة إذا سلمت عليه، ويظن أن النساء أيضا لا يسلمن على الرجال ولا يشمتن عاطسا، فيتكلم مع المرأة في أمور الدنيا لكن إذا عطس لا تشمت له، وإذا سلم لا ترد عليه ولا يرد عليها، فتركا الأمر الواجب المأمور به شرعا الذي هو من الحقوق الشرعية حقوق الأخوة الإسلامية، وهو يخوض في الحديث وأطرافه بل ربما كان الحديث الذي يخوضان فيه مما لا يحل الخوض فيه أصلا كالخضوع بالقول وأحاديث الريبة يتكلمان في الريبة ولا يرد أحدهما السلام على الآخر ولا يشمته إذا عطس، ولا شك أن هذا جمع بين الإفراط والتفريط، ونجد بعض الناس لا يدخل على النساء في بيت إذا أراد تدريسهن يجعل بينه وبينهن حائلا مثلا، أو يأمرهن بمغادرة المسجد، أو يمنعهن من الذهاب إلى الدروس، أو يمنعهن من الذهاب إلى المحاضرات وكل هذا مخالف للمنهج النبوي فإن رسول الله (ص) قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وكان يدرس النساء وكن يجلسن إليه، وقد قلن له يا رسول الله أنا وافدة النساء يقلن إن إخواننا من الرجال غلبونا عليك فاجعل لنا يوما من نفسك فجعل لهن يوم الخميس، ولم يكن رسول الله (ص) يجعل بينه وبين النساء حاجزا، بل كن يصلين معه في المسجد، فكان يقول: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وكان يأمر الرجال أن لا ينصرفوا حتى ينصرف النساء، وكان يأمر النساء أن لا يرفعن أبصارهن حتى يجلس الرجال من السجود لئلا ينكشف عليه شيء من عورات الرجال، وكن يشهدن معه الفجر متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، وكن يشهدن معه صلاة العيد والاستسقاء والجمع، وفي حديث أم عطية كنا نأمر بإخراج العواتق والحيض وربات الخدور يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين، وكان رسول الله (ص) يسلم عليهن، ويرد عليهن السلام ويعودهن إذا مرضن، وكان أصحابه يفعلون، وفي صحيح البخاري أن أبا بكر قال لعمر بعد موت النبي (ص) تعال بنا نزر أم أيمن كما كان رسول الله (ص) يزورها، فلما دخلا عليها بكت فقالا لها: أما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله (ص) من هذه الدنيا، فقالت: أما إني لا أبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله (ص) من هذه الدنيا ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء فهيجتهما على البكاء فبكيا ثم قاما، وكان عمر رضي الله عنه يزور العجائز من الأنصار ويخدمهن فكان يحتلب الشاة لعجوز من الأنصار يحلب لها شاتها، وخرج ذات ليلة يعس فسمع عجوزا من الأنصار تضرب وبرا وهي تقول: «على محمد صلاة الأبرار** صلى عليك الطيبون الأخيار** قد كنت قواما بكا بالأسحار** يا ليت شعري والمنايا أطوار** هل تجمعني وحبيبي الدار» فجلس عمر على بابها يبكي، حتى طلع الفجر، وقد خرج رسول الله (ص) ذات ليلة في زقاق من أزقة المدينة، فمر على باب عجوز من الأنصار فإذا هي تقرأ القرآن فوقف رسول الله (ص) يستمع إلى قراءتها فقرأت قول الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، فقال رسول الله (ص) نعم أتاني نعم أتاني، وجلس يبكي، فلذلك لا بد أن نعلم أن المنهج المستقيم في خلطة النساء يقتضي هذا، ولا إفراط فيه ولا تفريط، لا يمكن أن نتتبع جزئيات هذا الموضوع لكن تكفي اللبيب الإشارة، وقد علم أن المنهج المستقيم منهج وسطي في كل الأمور، صغائرها وجلائلها، وأن الإفراط في كل أمر مقيت شرعا وأن التفريط مذموم، وأن كل فضيلة بين رذيلتين، وقد عرف ذلك بالأمثلة التي ذكرناها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. |
| الأربعاء, 08 ديسمبر 2010 15:28 |
آخر تحديث للموقع: الجمعة, 14 فبراير 2025 13:52