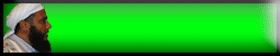| عداوة الشيطان |
|
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فإن العاقل الذي يدرك أنه في مواجهة وحرب لا بد أن يعد العدة لتلك المواجهة، ولا بد أن يميز بين عدوه وصديقه، وإننا في هذه الدار قد كتب الله علينا جبهات مفتوحة، ومن أخطر هذه الجبهات وأنكاها وأشدها جبهة إبليس، لكثرة جنوده وتنوعها، فإن له جنودا من الإنس وجنودا من الجن، وإنه قد أقسم بعزة الله ليغوين أكثر البشر وقد تحققت يمينه في أكثرهم كما أخبر الله بذلك: {قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين}، وقد قال الله تعالى: {ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين}، فصدقت يمينه في إغواء أكثر البشر، ولهذا قال الله تعالى: {ولكن أكثر الناس لا يؤمنون}، وقال: {وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله}، فأكثر الخلائق هم من جند إبليس، وهذا يدلنا على أن الكثرة ليست ملازمة للنصر، بل قد قال الله تعالى: {كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله}، ولا شك أن الله حكم بالفلاح والفوز لحزبه الموحدين، وحكم بالخسران والهلاك على حزب الشيطان الخاسرين، فقال تعالى: {إن حزب الله هم المفلحون}، وقال: {إن حزب الله هم الغالبون}، وقال: {إن حزب الشيطان هم الخاسرون}، إن اتخاذ الشيطان عدوا يقتضي منك أن تنقص جنده، وإن نقص جنده لا يمكن أن يتحقق إلا بإرادة ذلك والسعي من أجله، فهذا الذي يتقبله الله، وهذا الذي يثاب الإنسان عليه، والانتصار الحقيقي على الشيطان ليس بقتل أكبر عدد ممكن من أتباعه وجنوده، بل بإعادتهم إلى رشدهم وجعلهم في الحزب الآخر حزب الله، فنقل الأفراد من أن يكونوا من حزب الشيطان وجنده إلى أن يصبحوا من حزب الله ومن المجاهدين في سبيل الله هو أعظم انتصار على إبليس، ولهذا قال رسول الله (ص) لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أعطاه اللواء يوم خيبر: فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، إن نقص جنود إبليس هو واقع العداوة له، وهو الذي تستطيع أن تضره به لأنك لا تستطيع أن تقتله، فقد ضمن الله له البقاء مدة هذه الدنيا: {إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم}، ولا يضره ما يوجه إليه من الكلام الخبيث فقد لعنه الله، فبما ذا تضر إبليس إنما تضره وتحقق عداءك له بنقص أعوانه، وأبلغ ذلك أن تدخلهم في حزب الله وأن تجعلهم من الناصرين لله، ولذلك فإن رسول الله (ص) حين عرض عليه ملك الجبال أن يصدم الأخشبين على أهل مكة، قال: لا فإني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم رجالا يعبدون الله لا يشركون به شيئا، فانتصار رسول الله (ص) على إبليس هو بوقوف خالد بن الوليد في الصف أمام حزب الشيطان يجاهد في سبيل الله، ووقوف أبي سفيان بن حرب تحت راية رسول الله (ص) يجاهد في سبيل الله وقد فقد عينه اليمنى يوم الطائف تحت لواء رسول الله (ص)، وفقد عينه اليسرى يوم اليرموك تحت لواء ابنه يزيد، كل ذلك في سبيل الله، وهذا الانتصار من مظاهره أيضا وقوف صفوان بن أمية بن خلف يقاتل في سبيل الله ويغزو الروم في ديارهم رافعا لواء التوحيد، ومن مظاهره خروج عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام رافعا سيفه في وجه الأعداء الذين دعا الله الأعراب لمجاهدتهم وهم بنو حنيفة باليمامة، فقد أنزل الله على رسوله (ص): {قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما}، فكان عكرمة بن أبي جهل أحد قادة الإسلام المجاهدين لأولئك القوم والذين أبلوا بلاء حسنا، ومن مظاهر انتصار رسول الله (ص) على إبليس أن أبناء المشركين الذين تربوا على الشرك في أحضان آبائهم وأمهاتهم هم الذين كانوا يكسرون الأصنام كأولاد عمرو بن الجموح الذين كانوا يلطخون صنمه بالنجس وربطوه مع كلب ميت ورموا به في بئر، فكان ذلك سبب إسلام عمرو بن الجموح، إن الانتصار على إبليس ممكن في كل العصور، وهو أن يقصد الإنسان عدوا من أعتى أعداء الله ووليا من أولياء إبليس فيسعى لهدايته ويسعى لإقامته في الصف المؤمن المجاهد في سبيل الله الرافع للواء الإسلام، فإذا تحقق له ذلك فقد استطاع أن ينتصر على إبليس وأن يحقق نصرا في هذه الحرب الطويلة الأمد مع هذا العدو اللدود، إن لإبليس مكايد كثيرة من أعظمها أنه لا ييأس من الإنسان إلا عند النزع، فلا يزال يطمع في صرف الإنسان عن سبيل الله مدة حياته، يحاول معه الوقوع في الشرك سواء كان قاصدا عامدا أو كان غافلا أو جاهلا يوقعه في الشرك بالله، وقد كان رسول الله (ص) يستعيذ بالله من ذلك فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، فإذا يئس من إدخاله في الشرك حاول إيقاعه في إحدى الموبقات وكبائر الذنوب والفواحش، فإن عجز عن ذلك حاول أن يثنيه عن أداء فريضة من فرائض الله وركن من أركان الإسلام، فإن هو عجز عن ذلك حاول أن يوقعه في اللمم بصغائر الذنوب لعلها تقوده إلى الكبائر، فإن هو عجز عن ذلك حاول أن يترك بعض السنن المكملة للفرائض لعل الفرائض يدخلها النقص، فإن هو عجز عن ذلك حاول أن يوقعه في المكروهات التي تهوي به إلى المحرمات إن هو استرسل فيها، فإن هو عجز عن ذلك حاول أن يترك بعض المندوبات التي هي سياج دون السنن والسنن سياج دون الفرائض، فإن هو عجز عن ذلك حاول أن يوقعه في خلاف الأولى حتى يخسر بعض وقته ويضيع منه بعض عمره، فإن هو عجز عن ذلك حاول شغله بالمندوب عن الواجب وبالمفضول عن الفاضل، فإن هو عجز عن ذلك حاول أن يوقعه في الغلو في الفرائض حتى يزيد فيها عن الحد المطلوب، فإن هو عجز عن ذلك حاول معه الغلو أيضا في بغض المحرمات والابتعاد عنها حتى يترك بعض ما هو حلال له فيحرم ما أحل الله فيقع في النقص من وجه آخر، هذه المحاولات المتتالية هي شبكة من شباك إبليس يحاول بها اصطياد عباد الله، ويوقع بها كثيرا من الضحايا كل يوم، وهي أنكى وأشد من وقع الصواريخ والطائرات والدبابات، ثم إن لإبليس جندين قائمين أحدهما جند الشهوات والثاني جند الشبهات، أما جند الشهوات فهو ينقسم إلى قسمين، إلى الشهوات الحسية كشهوة البطن والفرج، وإلى الشهوات المعنوية كحب الرئاسة وحب الانتصار والولع بنقد الآخرين والكلام فيهم، وهذا الجند وهو جند الشهوات قل من ينجو من الوقوع فيه في كل عمره، فكثيرا ما يكون الإنسان في ساعة ضعف فيستهويه الشيطان لشهوة من الشهوات، إن استطاع أن يوقعه في الشهوات الحسية كحال كثير من الذين وقعوا في شراك إبليس وخداعه استجاب لذلك، فإن سمت نفسه عن ذلك ولم تكن الدنيا مؤثرة عليه حاول إيقاعه بالشهوات المعنوية، فإن هو عجز عن ذلك حاول أن يزين له نوعا من الشهوات من جنس آخر وهو حب الاطلاع على ما يكتمه الآخرون عنه، أو حب نقدهم حتى يجعل من نفسه حكما عليهم، أو أن يحاول في هذه الشهوات أن يجعل العبادة شهوة لديه، فيمارسها بطريق الشهوة لا بطريق التعبد، فيذهب إلى الصلاة متطهرا متوضئا لكن لا يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله، وإنما يفعله عادة وشهوة جرى عليها وتعود عليها من لدن آبائه وأجداده، أما الجند الثاني وهو جند الشبهات فهي تنقسم إلى قسمين أيضا، إلى شبهات في التعامل مع الله وشبهات في التعامل مع الناس، ثم الشبهات في التعامل مع الله تنقسم إلى قسمين، إلى شبهات عقدية وشبهات تعبدية، أما الشبهات العقدية فلا يزال يلقي على الإنسان من أنواع الشبهات حتى يقول له: هذا العالم خلقه الله فمن خلق الله، كما أخبر بذلك رسول الله (ص)، ولا يزال يشككه في الأمر الذي لا ريبة فيه ولا يشك فيه إلا من عطل عقله وفطرته وابتعد عن دين الله بالكلية، إن الإنسان ليعجب إذا سمع كلام بعض الذين وقعوا في حبائل إبليس وشراكه في الشبهات العقدية، كيف تشبثوا بما هو أضعف من نسج العنكبوت، وكيف تركوا وراءهم كتاب الله المحكم والسنة الصحيحة الصريحة وتشبثوا بالموضوعات والضعاف والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وهم يتركون وراءهم الوحي البين السافر الذي هو كالشمس في رابعة النهار، إن هذا من العجائب لكن من عرف طريقة إغواء إبليس للناس عرف أنه لا يستغرب عليه مثل هذا النوع من الخداع، فنحن نرى بعض أعوان إبليس من الإنس يخدعون الناس بأنواع الكلام الذي هو من جنس السحر كما بين النبي (ص): إن من البيان لسحرا، فيوقعونهم بذلك في الأخطار والأخطاء، فكيف لا يكون إبليس الذي هو قائد هذا الحزب والذي ألهم أنواع الشبه كيف لا يكون مقتدرا على مثل هذا النوع من التخليط على الناس والتلبيس عليهم، إن العجيب أن بعض الذين يلبس عليهم فيتشبثون بما هو أوهى من نسج العنكبوت لا يهتمون في كثير من الأحيان بدراسة ما هو نافع، ولا يدرسون العلم الصحيح، وإنما يبحثون عن متشابهات من الكتاب أو متشابهات من السنة أو ضعاف لا تقوى إلى درجة الاحتجاج فيتشبثون بها ويتركون وراءهم الحق المبين الواضح الذي لا لبس فيه ولا خفاء، إن من أغرب الغرائب ما يحدث به بعض المصلحين في هذا الزمان أنه لقي رجلا من الذين يتشبثون بهذا النوع من التعللات فسأله عن حكم شرعي فبين له ذلك الحكم بدليله من الكتاب وبعدد من الأحاديث التي تدل عليه، فقال: لكن ورد في أثر موقوف رواه الترمذي الحكيم بلا إسناد في نوادر الأصول كذا وكذا، فقال: أبهذا تعارض كلام الله وسنة رسول الله (ص)، إن هذا هو من فعل إبليس، وهو الذي يجعل كثيرا من الناس يجمع الحجج الواهية والمترديات والنطيحات لأمر ليس له به علاقة وهو في غنى عنه، والدين كله في غنى عنه، وإنما تشبث به لأن إبليس ربط رأسه فيه، وعقد عليه العقد فلا هو يستطيع الخلاص من شبكة إبليس التي عقد على رأسه بوجه من الوجوه، كذلك فإن من أنواع الشبه العقدية التي يلقيها إبليس أيضا ما يتعلق بهواية تكفير الآخرين أو تضليلهم أو الغلو في نصوص الشرع أيضا في المقابل، فقد ذكرنا أن إبليس لا ييأس ولا يقنط إلا عند الموت، فإذا وجد إنسانا مستقيم العقيدة في ذاته وأيس أن يوقعه في هذه الشبهات العقدية حاول أن يوقعه في نوع آخر من الشبهات العقدية وهو أن يحكم على الآخرين بالغلو وأن يخرج عن الجادة، فبدل أن كان طالب علم أو حتى عالما أو داعية انتقل إلى قاض يحاكم الآخرين دون أن يستدعيهم ودون أن ينظر في البينات والدعاوي ويصدر الأحكام دون أن يتأهل لذلك، إن هذا لا شك من كيد إبليس وهو سبب لحصول الفرقة والنزاع في البشرية، وهذا من أهم ما يسعى إليه إبليس، فقد صح عن رسول الله (ص) أن لإبليس عرشا على الماء يبث سراياه في الليل، فيأتيه أحدهم فيقول: ما زلت به حتى زنى، فيقول ما فعلت شيئا لعله يتوب فيتوب الله عليه، فيأتيه آخر فيقول: ما زلت به حتى قتل، فيقول: ما فعلت شيئا لعله يتوب فيتوب الله عليه، فيأتيه آخر فيقول: ما زلت به حتى شرب الخمر فيقول ما فعلت شيئا لعله يتوب فيتوب الله عليه، فيأتيه آخر فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين أهله فيدنيه ويقبله ويقول: أنت ابني، إنه يسعى للتفرقة بين الناس بكل وجه من الوجوه، ويسعى لأن يحدث بينهم العداوة والبغضاء، فهذا سعيه ويتخذ لذلك الوسائل المختلفة كشرب الخمر وكالصفقات الربوية، وكأنواع القمار والميسر كل ذلك من وسائل إحداث البغضاء والشحناء بين الناس، وقد ذكر أهل العلم من المتأخرين أن السياسة لدى المتأخرين وبالأخص في العالم العربي هي مثل الخمر والميسر يريد الشيطان أن يوقع بها العدواة والبغضاء بين الناس، ولذلك تشهدون في بلادنا أن أرحاما كثيرة قطعت بسبب خلافات سياسية وانتماءات لأحزاب، وفي بعض الأحيان في داخل حزب واحد، تتنافس الأسرة الواحدة فيقع بينها من البغضاء والشحناء وقطيعة الرحم ما الله به عليم، فقد قال الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون}، إن هذه الصلاة هي التي تجمع القلوب وتؤلفها على الحق، وإن ذكر الله هو الذي يزيل العداوة والبغضاء {ألا بذكر الله تطمئن القلوب}، لأنه هو الذي يفر منه إبليس، إن هذه الشبه العقدية الكثيرة تنتشر عندما ينشغل الناس عن الجهاد في سبيل الله وعن غزو العدو، فإذا تراجع المسلمون وانكفأوا على الخلافات الداخلية فيما بينهم انتشرت بينهم البدع المضلة، فلم تشع هذه البدع والشبهات العقدية في أوقات الجهاد والاستشهاد والنصرة، عندما تنطلق جيوش المسلمين غازية إلى مشارق الأرض ومغاربها لا تسمع لأهل الأهواء والفرق أي قول، ولا ترى لهم أية كلمة، لكن عندما ترجع الجيوش ويركن الناس إلى الراحة وينشغلوا بأمور الدنيا يقوم قائم الفتنة، ويصدح داعيها رافعا عقيرته ورافعا لواءه، فيجتمع حوله من أضلهم الله، إن هذا جرب في تاريخ الإسلام كله، وقد خاف الصحابة رضوان الله عليهم عندما رأوا كثيرا من الناس فتحت عليهم الدنيا أبوابها فأقبلوا يهدبونها، ولم يخرجوا في الشاتية ولا في الصائفة، فرأوا أن جلوس هؤلاء مظنة لانشغالهم بالشبه العقدية، وهذا ما حصل فقد قامت فرقة القدرية ثم فرقة الجبرية وقبل ذلك فرقة الخوارج وبعدهم فرقة الشيعة وهكذا، أما النوع الثاني من شبهاته في التعامل مع الله فهو الشبهات التعبدية، فما نراه من الوساوس لدى الناس في الطهارة والصلاة وفي غير ذلك من أنواع العبادات كله من سعيه الحثيث، فإنه يسعى لتقليل شأن العبادة لدى الإنسان حتى لا تكون ذات بال في تصوره، ومن علامات ذلك صعوبتها على الإنسان وتكاسله فيها، فإذا رأيت الإنسان يستطيل صلاة عادية وتشق عليه وتمر الصلاة من أولها إلى آخرها دون أن يحضر في ركن منها، ورأيته إذا أطال الإمام القراءة أو أطال الركوع أو السجود تضجر وشكا وهو يمكث الساعات بعد الساعات في متجره، بل ربما مكث ساعة في انتظار سيارة الأجرة على الشارع فاعلم أن الشيطان قد أخذ بزمامه في هذه الشبهات التعبدية، وهو في الشبهات التعبدية، قد بنى سورين كبيرين أحدهما سور الإفراط والثاني سور التفريط، وجعل في هذين السورين أبوابا يدخل من كل واحد منهما من استجاب له، فيحاول مع الإنسان أن يكون مفرطا أولا مقصرا في العبادة، ولذلك تجدون المساجد تمتلئ في أوقات الأعياد والجمع، وتجدونها لا يصلي فيها غير صف أو صفين في صلاة الفجر، إنما ذلك لأن الشيطان يعقد على قوافي رؤوس الناس ثلاث عقد يضرب في كل عقدة إن عليك ليلا طويلا فنم، كذلك في مجال المنافسة في الطاعات الأخرى كنا من قبل نشهد تنافسا على حلقات العلماء والجلوس إليهم وتنافسا في حفظ كتاب الله وقد بدأ ذلك يتناقص مع تزايد الناس، فليس بالناس من قلة، ولكن مريدي الخير قد بدؤوا في التناقص، وما ذلك إلا بإغوائه بما يحدثه من أنواع الانشغالات، وبِهَيْعاتِه وصيحاته التي يخرجها من خلال التلفزيونات، والقنوات الفضائية ووسائل الإعلام الأخرى فهي تشغل الناس عن العلم النافع، وتشغلهم عما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، وانظروا إلى أولاد الأسر الكريمة الذين كان آباؤهم إذا بلغوا السن التي هم فيها يذهبون إلى المحاضر ويدرسون على المشايخ ولا يرجعون إلى أهليهم إلا وقد أحرزوا علما نافعا، وهم الذين يرجع إليهم عند تجهيز الجنائز أو عند إمامة الصلاة أو عند عقد النكاح، وهم اليوم لا يرفع إليهم أحد رأسا بأي شيء من مهمات الدين، إن هذا واقع منتشر، ومن أنف منه أو ظنه طعنا فيه فليراجع نفسه ومسيرته، وليقارن بين حاله وحال آبائه من قبل، كذلك من أنواع الشبهات التعبدية التي يلقيها ما يتعلق بالسور الآخر وهو سور الإفراط، فيسعى ببعض الناس إلى أن يشغلهم بأمور الآخرة عن أمور الدنيا، أو ببعض أمور الآخرة عن بعض، فيحرم الإنسان في الصلاة ولديه خطاب موجه إليه من رب العزة في كل قيام وركوع وفي كل خفض ورفع فيشغله بأمر من أمور الآخرة وبتذكر حال من أحوالها أو بتذكر واجب من واجباته الأخرى فينشغل بذلك عن أداء الصلاة، فلا هو أصلح ذلك الواجب وقدمه على الصلاة ولا هو أصلح الصلاة لانشغاله عنها، وهذا النوع من الغلو منتشر كذلك بين الملتزمين من الناس، فأعرف أقواما كانوا أهل ضلالة وغي فهداهم الله للإسلام لكنهم دخلوه من زاوية ضيقة، وأرادوا أن يحجروا واسعا وأن يضيقوا هذا الشرع الذي وسع الله فيه على عباده، واشتغلوا بصغريات الأمور عن كبرياتها، وعاشوا مع الأوهام وهم بذلك في جهاد في غير محله وحرب على غير أهلها قد انشغلوا بجزئيات يسيرة هي بمثابة القذى الذي يكون في طرف العين وتركوا طوام ومشكلات كبرى انشغلوا عنها بما هو دونها، فجعلوا من الحبة قبة، ومن الأمر اليسير خطبا كبيرا، إن ذلك النوع من الغلو هو الذي أصاب النصارى عندما ابتدعوا رهبانية لم يأذن الله بها ولم يأمرهم بها فانعزل رجال الدين منهم في الصوامع وانقطعوا عن الدنيا، ومنعوا أنفسهم ملذاتها وشهواتها، وعندما خرج عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام رأى الرهبان في الأديرة فرأى إقبالهم على العبادة وتفانيهم فيها وبكاءهم فبكى بكاء شديدا فقيل له: يا أمير المؤمنين وما يبكيك؟ فقال يبكيني حال هؤلاء هم الذين قال الله فيهم –في خواتيم سورة الكهف- {قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا}، فأولئك يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم الذين قد ضلوا سواء السبيل، ولا يغني عنهم ما فعلوا شيئا، وأعمالهم كلها ستكون هباء منثورا يوم القيامة، إن ذلك النوع من الغلو لا يزال يوجد ولهذا نجد الذين يسلمون اليوم من النصارى يدخلون الإسلام يبحثون فيه عن الرهبانية، فكثيرا ما يلتصقون ببعض البدع المضلة، أو يأوون إلى أهل البدع لأنهم يرون فيما لديهم شبها بما كانوا يفهمون الدين عليه في أيام جاهليتهم وشركهم، فكثيرا ما يأوون إلى صوامع أهل البدع وكثيرا ما يلتحقون بهم، لأنهم فهموا الدين من خلال تلك الزاوية، وعندما دخلوا في هذا الإسلام تلمسوا فيه ما يشبه الدين في تصورهم لما كانوا نصارى فلم يجدوا إلا تلك البدع فالتحقوا بها والتصقوا، أما النوع الثاني من أنواع الشبهات فهو الشبهات في التعامل مع الناس، وهي كذلك تنقسم إلى قسمين، القسم الأول فيما يتعلق بتقويم الناس، فإن كثيرا من الناس لا يقيس الآخرين إلا من خَرْتِ إبرة، ولا ينظر إليهم إلا بنظرة فوقية وازدراء، فأهل الإيمان عنده ليسوا في حصن حصين، وأهل الطاعة والعبادة عنده ليسوا بمنأى من النقد والطعن في محل ذلك، وهذا النوع من الناس تجدهم لا يبالون بصلاة ولا بصيام ولا بدعوة ولا بجهاد لكنهم كلما رأوا مقبلا على الله في أي أمر من الأمور بدؤوا يسبونه ويشتمونه ويطعنون في نيته ويقولون ما فعل هذا إلا رياء وتسميعا، وما فعل كذا إلا إحداثا ويظنون أن كل ما لم يعرفوه من الدين فهو ابتداع جديد أو دين مستورد وأولئك الغاوون لم يعرفوا من الدين إلا اسمه، ولا عرفوا من السنة إلا رسمها، ولا سلكوا طريقا من طرق الهداية أبدا، بل ما هم إلا أمثال الذباب الذي لا ينزل إلا على القذر يتلمسون الأخطاء، ويتركون الروضات الغناء، فهم مشغولون بالتماس عثرات الآخرين وزلاتهم، وأولئك جدير بهم أن يعرفوا قدر أنفسهم وأن يراجعوا حالهم، وأن يتذكروا أن عليهم كراما كاتبين حفظة لا يفرطون ولا يضيعون، وأن الآخرين كذلك عليهم من يكتب أعمالهم، فلا يحتاج إلى تصويب أولئك وتخطئتهم، ولا إلى طعنهم ونقدهم، إن هذا النوع من الطعن في الناس في تقويمهم هو سبب طعن الخوارج في أصحاب رسول الله (ص)، فقد زعم قوم من شباب بني أسد بن خزيمة بالكوفة أن سعد بن أبي وقاص لا يحسن الصلاة، فشكوه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأله فقال: والله إني لأصلي لهم صلاة رسول الله (ص)، أركد في الأوليين وأخف في الأخريين، فقال: ذلك الظن بك، يطيل الركعتين الأوليين ويخف في الركعتين الأخريين، وهكذا كانت صلاة رسول الله (ص)، فقال عمر ذلك الظن بك، فقال سعد في خطبته: والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع رسول الله (ص) وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام خبت إذن وضل سعيي، وكذلك فإن الشباب المتحمسين من الخوارج عندما صاحوا بعلي رضي الله عنه لقد كفرت كفرة شنعاء، قال: ويلكم كيف أكون أول من صدق به وأكفر به بعد موته، إن أولئك الذين قد غلوا في التعامل مع الناس وفي تقويمهم لا ينظرون إلى أحد على مقتضى سابقته في الإسلام، فهؤلاء الصحابة الذين تكلموا فيهم شهد لهم رسول الله (ص) بالتعيين بالجنة، وأنزل الله في كتابه رضوانه عنهم وأنه لا يضرهم ما فعلوا، فمن رضي الله عنه رضاه الأكبر الذي لا سخط بعده لا تقع ذنوبه إلا مغفورة، ومع ذلك يقومهم هؤلاء الذين لا يبلغون أن يصلوا إلى شسع نعل أحد أولئك بل ولا إلى غبار فرسه في يوم واحد في سبيل الله، ولهذا قال مالك رحمه الله لأحدهم عندما سمعه يلعن بعض المهاجرين والأنصار دعاه فقال له: أأنت من المهاجرين الأولين؟ قال: لا، قال: أفأنت من الأنصار الذين آووا ونصروا؟ قال: لا، قال: فأنا أشهد بالله أنك لست من الذين اتبعوهم بإحسان، فقد قال الله تعالى: {والذين جاؤوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان}، وأنت تلعنهم، كذلك فإن من هذا النوع من الغلو غلوا آخر بالإفراط في الأشخاص وتقديسهم، فالأشخاص بعد رسول الله (ص) ما منهم معصوم، هم مجتهدون يخطئون ويصيبون، لكننا نقدر أهل الخير ولا نقدسهم، ولذلك أجمعت الأمة على أن فعل غير المعصوم ليس بحجة، هؤلاء الصحابة الكرام الذين تحدثنا عن بلائهم في الإسلام وأثرهم فيه وسابقتهم فيه، وما شهد الله لهم به ورسوله (ص) مع ذلك ما فعلوه من الأخطاء إذا أراد أحد أن يقتدي بهم فيه لا نقبل منه ذلك، لأننا نعلم أنه خطأ لكنه خطأ مغفور في حق الصحابة، ولا ندري هل يغفر في حق من يقتفي أثرهم فيه أو لا يغفر، فلذلك نمنعه من الوقوع فيه ونحول بينه وبينه، وهذا مقتضى تقديرنا لهم لا مقتضى التقديس الذي يأخذ به بعض الناس حتى فيمن دون الصحابة، فإن كثيرا من الناس يقدس بعض الأحياء وبعض الأموات الذين عاصرهم، فلا يستطيع أن ينتقد عليهم ما خالفوا فيه شرع الله أبدا، ولا يجعلهم محلا للتعقب في أي وجه من الوجوه، بل يرى أن من خالفهم ولو فيما له فيه دليل قوي يستحق من العقوبة ما استحقه سحرة فرعون أن يصلبوا على جذوع النخل، إن هذا النوع من تقديس الأشخاص هو من إغواء إبليس للناس، ثم إن من أنواع الشبهة فيما يتعلق بمخالطة الناس نوعا آخر من أنواع الشبهات يقتضي من الإنسان أن يحاول أخذ حقه جميعا، وأن يحاول أن يفرط في حقوق الناس ما استطاع، فيحاول أن يبخس الناس أشياءهم وأن ينقص من حقوقهم ما استطاع، وأن يكون حقه هو موفورا كاملا لا يعتريه النقص بحال من الأحوال، وهذا هو تمام التطفيف الذي قال الله فيه: {ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين}، أذكر أن رجلا زار قريبا له فذكر له رحما بينه وبينه، وهو يريد منه حق تلك الرحم، فقال: على الرأس والعين لكن: ألا تذكر أن لي نظير هذا الرحم أيضا، فإذا كان الحق له جاء يريد حقه، وإذا كان الحق للآخر لم يعترف به، فهذا النوع من أنواع الشبهات منتشر كذلك في الناس، وسبب النوعين اتساخ البصيرة وإظلامها بسبب ما يتراكم فيها من المعاصي، فإن معاصي الله إذا تكاثرت اسودت البصيرة، فلم يكد الإنسان يميز بين الحق والباطل، ولم يكد يميز بين الصواب والخطإ «إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه** وصدق ما يعتاده من توهم** وعادى محبيه بقول عدوه** فأصبح في ليل من الشك مظلم» ثم إن هذين الجندين من جنود إبليس وهما الشبهات والشهوات لا يمكن أن يقف في وجههما إلا الصبر واليقين، فالصبر هو الذي يقف دون الشهوة فلا يواقعها الإنسان ويصبر عن الشهوة الفانية طمعا ورغبة في الشهوة الباقية، يرغب في جنات النعيم، يرغب في جوار الله عز وجل في الفردوس الأعلى من الجنة تحت عرش الرحمن، يرغب في أن يذكر اسمه في الملإ الأعلى في أن يتقرب الله إليه، فإذا تقرب هو شبرا تقرب الله إليه ذراعا، وإذا تقرب ذراعا تقرب إليه باعا وإذا أتاه يمشي أتاه هرولة سبحان ربنا ما أكرمه وأحلمه، وبذلك لا يمكن أن تغويه هذه الشبهات، فبينه وبينها حاجز حصين، لا يمكن أن يقع فيها، وإذا استزله الشيطان فوقع في طرفها تذكر فبادر للتوبة والاستغفار، {إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون}، إن عداوة إبليس للناس بينة واضحة، لكن مظاهرها غير مدروسة لدى كثير من الناس، فكثير من الناس تخفى عليه هذه المظاهر، فأعرف بعض الناس يتفانون في إتقان عملهم ووظائفهم وهم بذلك يظنون ذلك قربة وحمدا، وهو في الواقع قربة وحمد لدى إبليس فقط، ترى الرجل وظيفته أصلا في عمل محرم، فهو يتقنها ولا يفوته شيء من الوقت، ولا يقصر في تلك الوظيفة التي هي حرام ومحادة لله ورسوله، ولا يحسب عليه يوما من الأيام أنه غاب أو تخلف عن وقت الدوام المحدد، وهو بهذا يظن أنه يحسن عملا وأنه يقدم خدمة، والواقع أنه إنما يتقرب من إبليس بذلك الذي يعمله، إن إبليس يلبس عليه بأنه مرتبط بعقد وأنه يأخذ مرتبا على هذا العمل فيلزمه إتقانه وإصلاحه، لكن الواقع أن ذلك العقد في أصله لاغ، فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو بعقده الذي يحاد به الله ورسوله كان جديرا به أن يخرج منه فإذا لم يجد معاشا إلا أن يأخذ من ملح الأرض فيبيعه أو من حطبها، أو أن يجلس في بيته فيتصدق عليه المسلمون لكان ذلك خيرا له من مثل هذا العمل الذي هو محادة لله ورسوله، وتجد آخرين يتكسبون بالحرام البين ويقولون قد ذكر بعض أهل العلم في شواذ الأقوال أن التكسب بالشبهة لا بأس به، هذا مناف للواقع فالذي تتكسب فيه ليس بشبهة، بل أنت تعرف أنه حرام، ولو راجعت نفسك واستفتيتها لما رضيت أن تلقى الله به تحمله على عنقك، ومع ذلك حتى لو كان شبهة فمن الذي أمر بالشبهات بعد أن نهى عنها رسول الله (ص)، وقال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، هل جاءك بعد رسول الله (ص) رسول من عند الله؟! إن ما جاء به رسول الله (ص) هو الحق الذي لا نسخ فيه ولا تعقيب ولا تغيير، وقد أنزل الله عليه: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا}، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، إن هذا العدو اللعين يلبس على الناس بأمور شتى، ففي تصوراتهم وعقائدهم ينطلقون من مبادئ ليست مما جاء به الرسول الكريم (ص)، وهم يلصقونها بما جاء به ويظنونها من تمامه، فيظنون أن ترك تلك البدع أو تلك الخرافات هو من نقص الدين وهو في الواقع سلامة الدين واستقامته، فلو راجعوا أنفسهم لعرفوا أن الدين لا يمكن أن يزداد بعد موت رسول الله (ص)، ولا يمكن أن ينزل وحي بعد انتقال رسول الله (ص) إلى الله، ومن أعجب ذلك أنني سمعت إماما لأحد المساجد المعتبرة يتحدث عن بدعة من البدع، يقول: نعم لم تكن معروفة في الصدر الأول، وإنما كانت مشروعيتها في القرن الرابع الهجري، من الرسول الذي بعث في القرن الرابع الهجري، وهذا إمام وخطيب يوجه المسلمين، فيقول: لم تكن معروفة في الصدر الأول وإنما كانت مشروعيتها في القرن الرابع الهجري، إن هذا النوع هو من تلبيس إبليس العجيب، وأنا متأكد أن هذا الإمام ما أراد إلا الخير، وأنه لو راجع نفسه قليلا قبل أن يتكلم لعرف أن هذا لا تتحمله الآبار، هذا الذي خرج من فمه الضيق لا تتحمله أفواه الآبار فكيف يتحمله فم هذا الإمام، كذلك نجد آخرين يأتون بأشياء من أمثال هذا عجيبة جدا يستنكرها العاقل غير المتعلم أصلا الذي لا حظ له من العلم، وإذا سمعها الصبي الصغير الذي هوعلى الفطرة قال: سبحانك هذا بهتان عظيم، ومع هذا تجد الكبار الذين يقتدى بهم يعتقدون صوابها وأنها هي الحق الذي لا غبار عليه، أذكر أن ولدا صغيرا ما زال يدرس في السنة الأولى من الإعدادية حدثه عمه أن أقطاب الأرض سبعة أحدهم هو الممسك بالسماوات والآخر هو الممسك بالأرضين، والآخر هو الممسك بالبحار والآخر هو الممسك بالجبال إلى آخر تلك القائمة، فقال له الولد: يا عم ماذا تركوا لربنا سبحانه وتعالى؟ ألم يقل الله تعالى: {إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا}، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، كيف يكون أولئك يمسكون بهذا الكون كله ولا يبقى لربنا سلطان سبحانه وتعالى؟ فلا شك أن مستوى الرجلين متفاوت في العلم، وأن الكبير على حظ من العلم لا يمكن أن يقارن بالصغير، لكن الصغير على الفطرة، والكبير قد تلبس بحبالة من حبالات إبليس، فهو يتردد فيها لا يعرف المخرج منها، ونظير هذا أن كثيرا من الناس إذا سمع من ينكر أمرا من البدع التي وجد عليها بعض الذين عاصرهم، ولا شك أنها لم تزل لها منكر في دين الله، لأنه لا يمكن أن يخلو عصر من قائم لله بالحجة، لا يخلو عصر من العصور في بلد من البلدان من قائم لله بالحجة ينكر ما أنكره الشرع، لكن مع هذا يتشبث هو بها تشبثا كبيرا، لقيت أحد الإخوة من أهل هذه البلاد فإذا هو منهمك في الدخان بأنتن ما يمكن أن يتصور، وصوت صدره وأزيزه كأزيز المرجل لشدة مرضه ولتأثر رئتيه بذلك، فقلت له: يا أخي ألا تعلم أن هذا مضر بصحتك وأنه لا خير فيه وقد نهيت عما فيه الضرر المحض البين؟ فقال: إن أبي رحمه الله كان من الصالحين والعلماء وقد كان يدخن، فقلت: يا أخي أنت لم تتبعه في العلم والصلاح، وإنما اخترت أخس ما لديه فاتبعته فيه، قد كان من العلماء والصلحاء ولم تتبعه في ذلك أنت لا تدعي علما وصلاحا أنت تدعي تدخينا فقط، وهذا أخس ما لدى والدك رحمه الله فلم تتبعه إلا في أرذل شيء، إن هذا النوع مع الأسف ما زال منتشرا في كثير من بيئاتنا وفي كثير من بلدان العالم الإسلامي، تجد الرجل ينقل النقاش عن أمر علمي ذي دليل واضح إلى أمر جانبي ليس محلا للنقاش، أو يرتب عليه من اللوازم ما لا يخطر على بال، فإذا حصل النقاش في مسألة علمية تتعلق ببعض حقوق الألوهية والفرق بينها وبين حقوق العباد نقل ذلك إلى حرب بينك وبين الرسول (ص) مثلا، وعندما تثبت حقوق الألوهية لله الواحد القهار وحده لا شريك له يشتد غيظه هو لأنه يظن أنك بذلك تتنقص رسول الله (ص)، ولا يدري هذا المسكين أن هذا الذي أتيت به هو الذي جاء به الرسول (ص) وهو الذي شرف من أجله، فالرسول (ص) شرفه برسالته التي أرسله الله بها، وهي رسالة التوحيد، وهي رسالة الإخلاص، {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة}، فهذا المسكين لا يدرك ذلك، بل يرى أن كل من بيَّن سنة من سنن النبي (ص) في التفريق بين حق الله وحقوق العباد أنه معاد لرسول الله (ص)، ويرى أن من أنكر على من ابتدع في دين الله ما لم يأذن به الله، وما لم يأت به رسوله (ص) هو بذلك مريد لهدم ركن من أركان اعتقاد الإسلام، أو أنه يريد قطع المدد الذي يأتي من الرسول الكريم (ص)، وهذا المدد الذي يتوهمه هو للبدعة ليس مددا من الرسول (ص) وإنما هو وحي من وحي الشيطان ومدد من مدد الشيطان، فالرسول (ص) مدده الإيمان والعلم والوحي المنزل، {قل إنما أنذركم بالوحي}، ولا يمكن أن يكون مدده الخرافة والبدعة المضلة، هذا لا يمكن أن يعقل بوجه من الوجوه، إن هذا العمل الذي سعى إليه الشيطان وأظهره واتبعه عليه غوغاء الناس يمكن أن يجد له الإنسان مساغا في الأوساط الجاهلة لكنه يستغرب انتشاره في الأوساط المتعلمة التي يقرأ أولادها الصغار كتاب الله ويكملوا حفظه في الثامنة، ويقرؤون ما تيسر من سنة رسول الله (ص) ومن أحكام الشرع، ومع ذلك تجري في عروقهم هذه الخرافة وهذا النوع من الدجل العجيب، إن هذا النوع من عمل إبليس لا بد أن يجد مقاومة، ولم يخل عصر من عصور هذه الأمة من مقاومة له، وفي هذه البلاد التي نحن فيها وهي بلاد العلم والعلماء لم يخل عصر من العصور من عدد من العلماء الذين ضحوا بعلاقاتهم وبمصالحهم في الناس يريدون نصرة الله ورسوله وإنكار الغواية والباطل ويقفون في وجه هذا الباطل وقوفا قويا، وقد يعانون بعض المضايقات والمشكلات لكنهم يصمدون ويصبرون، وأمثال هؤلاء كثير في كل عصر من عصور هذه الأرض، وفي كل زمان من أزمنتها، إن الرجال الذين كانوا يقفون لله سبحانه وتعالى بالحق في وجه إبليس ويكافحون انتشار الهوى في الناس قد قاموا بالحق الذي عليهم في زمانهم، وهذا الزمان زمانكم أنتم اليوم فأنتم المسؤولون وأنتم خلفاؤهم الذين بقيتم بعدهم، فما يحدث من العار والعيب أنتم تتحملونه ولا يتحمله الآباء والأجداد الذين قاموا بالحق الذي عليهم، وإن زمانكم ليس كزمانهم، فزمانهم كما ذكرنا ينتشر فيه طلب العلم، والناس يؤثرون فيه طلب العلم على طلب الدنيا، واليوم قد انتشر الجهل وطوي بساط العلم وأغلق كثير من محاضره، وأصبح الناس يترددون إلا من رحم الله في الجاهلية الجهلاء، فمسؤوليتكم أنتم يا معشر المؤمنين الموحدين المخلصين الصادقين أن تنصروا الله ورسوله، وأن تعيدوا الناس إلى المحجة البيضاء، وأن تقفوا لإبليس بالمرصاد، وأن يكون ذلك بلطف ولين ورفق، وأن يكون بوجه الصواب الذي جاء به النبي (ص)، وأن لا تخاطبوا الناس بالنابي الذي لا يؤثر إلا بالضد، وأن تقودوهم إلى الإسلام بأيسر السبل ومن أقصر الطرق وأن تكونوا بذلك ناجحين في دعوتكم سالكين طريق الأنبياء، إنكم إذا فعلتم ذلك حققتم عدواتكم لإبليس التي أمركم الله بها، وتخلصتم من الأهواء المضلة، وتخلصتم كذلك من حظوظ النفوس التي تدعوكم دائما لمحاولة الانتصار بالباطل، وإن من حقوق الناس عليكم أن تنصروهم على إبليس فهم في مواجهة معه، إن هذه المواجهة الضخمة تقتضي من أهل الفقه في الدين أن يأتوا باجتهاد صائب معاصر يسهل السبل على الناس في الأمور التي نشأت ولم تكن معهودة، فقد قال الإمام مالك رحمه الله: تحدث للناس أقضية على حسب ما أحدثوا من الفجور، وروي ذلك عن عدد من أئمة السلف، إنني أعرف أن عددا من الذين يملكون الأموال الطائلة التي أصلها من حرام وهم يتصرفون فيها اليوم يشق عليهم أن يتخلصوا من هذه الأموال، وذلك للمستوى الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشونه ويعيشه أولادهم من بعدهم، فعلينا أن لا نعين الشيطان عليهم، فإذا أردنا تخليصهم من الحرام فلنحاول أن نأتي باجتهاد جديد يخلصهم من الحرام ولا يوقعهم في الحرج، ولا يقطع عليهم الطريق للهداية والاستقامة، وقد اجتهدت فرأيت عملية تقتضي أن يخاطب أولئك التائبون بأن يقال لهم: حاسبوا أنفسكم وانظروا ما معكم من المال الحرام وخذوه على وجه القرض وسلموا منه كل فترة كذا وكذا لليتامى أو لجهات الخير في المسلمين أو للفقراء حتى من أقاربكم وبذلك تتخصلون من الحرام بالتقسيط والتدريج، وقد عرضت هذه الفتوى على رجال الاجتهاد والإفتاء من لقيت منهم فوافقوا عليها، وقد استجاب لها عدد من الذين تابوا وأنابوا نحسبهم كذلك والله حسيبهم، فاستطاعوا أن يتخلصوا من الحرام بالتقسيط، وأن تبقى أرباحهم وأعمالهم ملكا لهم ولأولادهم من بعدهم، إن هذا النوع يحتاج الناس إليه في زماننا حاجة كبيرة، فالذين لا يجتهدون مثل هذا النوع من الاجتهادات ربما قطعوا طريق التوبة والاستقامة على من يريدون التوبة، ومع ذلك ما زال لديهم ضعف أمام المغريات وأمام الأهواء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيها لأحد حظا ولا نصيبا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
|
| السبت, 11 ديسمبر 2010 18:20 |
آخر تحديث للموقع: الثلاثاء, 12 نوفمبر 2024 13:54