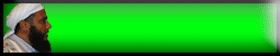| الجيل الرباني الأول |
|
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى ختم الأمم بهذه الأمة المشرفة العظيمة، التي جعلها خير أمة أخرجت للناس وشرفها بأنواع التشريف، فأرسل إليها أفضل الرسل، وأنزل عليها أفضل الكتب، وشرع لها خير شرائع الدين، وقد جعلها الله سبحانه وتعالى شهودا على الناس عدولا، فقال تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا﴾.وشرفها بأن جعلها أجيالا متفاوتة، وأفضل هذه الأجيال وأشرفها القرن الذين بعث فيهم رسول الله (ص)، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقد صح عنه (ص) أنه قال: خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وصح عنه (ص) أنه قال: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى من رأى من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، وذلك الجيل الأول الذين بعث فيهم رسول الله (ص) هم الإسوة والقدوة لمن يأتي بعدهم، فقد اختارهم الله لنبيه (ص) كما اختاره هو من سائر الخلائق، وشرفهم بصحبته والأخذ عنه والتربي على يديه (ص)، ولذلك نالوا من أجر السبق والتقدم في الإسلام ما لا يمكن أن يدركه من وراءهم، فقد قال الله في كتابه: ﴿لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى﴾، وصح عن رسول الله (ص) أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، إن تلك المنزلة العظيمة والمزية الكبيرة التي خص الله بها أصحاب رسوله (ص) مقتضية منا جميعا أن نحرص على الاقتداء بهم، وأن نحرص على أن نحاول أن نهتدي بهديهم، لعلنا نلحق بهم، فهم السابقون الذين وصفهم الله بالسبق في كتابه وأثنى عليهم به في كتابه، فقد قال الله تعالى: ﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه﴾، لذلك جدير بنا أن نتدارس حياتهم وآثارهم وأن نتعلم هديهم وسلوكهم، وأن نحاول الاقتداء بهم في الشأن كله، إن أولئك القوم لم ينالوا هذه المنزلة ولا هذا الشرف بوراثة عن آبائهم وأسلافهم، ولم ينالوه كذلك بالأموال والجمع لحطام الدنيا، ولم ينالوه بالشهادات الراقية، وإنما نالوه بأن أسلموا أنفسهم لله سبحانه وتعالى فصدقوا ما عاهدوه عليه ونصروا رسوله (ص)، واتبعوه وكانوا معه، فبذلك نالوا هذا الفوز العظيم، الذي لا يُصَلّي أحد منكم إلا دعا لهم به، ولا يمكن أن يفعل أي معروف إلا كان تابعا لهم فيه، فهم السابقون السابقون، هم المقدمون على الناس في كل شيء، لذلك جدير بنا اليوم أن نراجع بعض ما تقدم به أولئك الرهط، إن رسول الله (ص) بعث بمكة في بيئة جاهلية يظهر فيها من القيم كثير مما تعرفونه، فتلك البيئة كان أهلها يعبدون الأصنام من دون الله، وكانوا يشرعون لأنفسهم فهم الذين يحلون ما أرادوا ويحرمون ما أرادوا، وكانو يغيرون شرع الله عمدا ويفخرون بذلك، ويقول شاعرهم: «ونحن الناسئون على معد** شهور الحل نجعلها حراما» وكانوا كذلك يقطعون أرحامهم ويفسدون في الأرض، وكان الغني منهم يزداد غنى باستغلال الفقراء، والفقير يزداد فقرا لأنه لا أحد يرحمه، وكانوا كذلك يتقاتلون لأتفه الأسباب وأقلها، فقد كانت حرب البسوس قبيل بعثة رسول الله (ص)، ودامت ثلاثين سنة بسبب أن ناقة وطئت بيض قُبَّرَة فكسرتها، ودامت حرب داحس والغبراء أربعين سنة بسبب أن فرسا غلبت أخرى في الجَرْي، كانوا أهل جاهلية جَهْلاء بكل مفاهيمها، ومن أعظم ذلك أن من ليس من أهل الحُمْس لم يكن يطوف بالبيت الحرام إلا عريانا، وقد وقف أحد أصحاب رسول الله (ص) عند هذه القضية مثالا على جهل أهل الجاهلية وضعف عقولهم وتردي أوضاعهم، فقد جاءت امرأة فطلبت من يعيرها ثوبا لتطوف به فلم تنله، فأرسلت شعرها على جسمها، وقالت: «اليوم يبدو بعضه أو كله** وما بدا منه فلا أحله» وطافت عريانة، فذلك كان حال أهل الجاهلية في تلك الجاهلية الجهلاء، وفي تلك الظروف التي كان العرب فيها تحوط بهم الحضارات الكبرى كحضارة الروم بالشام وحضارة فارس بالعراق، وحضارة الحبشة بالقرن الإفريقي، في تلك الظروف كانت جزيرة العرب مقسمة في الولاء تبعا لهذه الحضارات والممالك الكبرى، فبعث الله محمدا (ص) بالبينات والهدى، في وسط جزيرة العرب في أم القرى، لينذر أم القرى ومن حولها، فعندما بعث بأبي هو وأمي (ص) هيأه الله لتحمل هذه المسئولية الجسيمة، فقد اختاره الله من أوسط نسب قومه، فهو أشرفهم نسبا، والأوسط بمعنى الأشرف والأفضل من ناحية الآباء ومن ناحية الأمهات، لا يمكن أن يغمز أحد فيه من جهة النسب لئلا يكون ذلك حائلا بين الناس وبين اتباع دعوته، وما هذا إلا لطف من الله سبحانه وتعالى بعباده الذين يعلم ضعفهم وأنهم يتبعون من عرفوا نسبه وعرفوا مكانته، وإلا فالأنساب لا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فالناس جميعا سواسية بين يديه وهم عباده جميعا، لكنه اختار أن لا يمتحنهم بما يتنافى مع طباعهم، فأرسل إليهم من هو أشرفهم نسبا، وكذلك هيأه في خلقته، فجعله أحسن الناس صورة، ولذلك وصفه من رآه بأن وجهه مستدير كفلقة القمر، وقال: هو عن نفسه أوتي يوسف شطر الحسن وأوتيت الحسن كله، وكذلك فإنه (ص) أتم الله خُلُقَه، فلم يكن يُعْرف أحدٌ أحسن منه خلقا، لا فيمن تقدمه ولا فيمن تأخر عليه، وعرف في الجاهلية قبل البعثة بالصدق والأمانة والإخلاص والكرم والجود والتفاني في خدمة الناس، ولذلك حينما بعث إليه فارتاع من الملك أول ما أتاه، قالت له أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتُكْسبُ المعدوم وتَقْري الضيف وتعين على نوائب الحق، فقد عرف بهذا (ص)، حتى لم يكن أحد يتهمه في مقال قاله، ولذلك عندما أذن له في الجهر بالدعوة، وقف على الصفا فصاح في الناس ثلاثا وا صباحاه يا آل عبد مناف، فاجتمعوا عليه فقال: يا بني عبد مناف، أليس إذا أخبرتكم أن وراء هذا الجبل خيلا ستغير عليكم تصدقونني، قالوا ما عرفنا عنك كذبا، فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فأعلن دعوته من ذلك المكان الشريف، وصدقوه لما عرفوا فيه من الصدق والأمانة والإخلاص والنزاهة، عندما بعث (ص) لم يتصل بعلية القوم وملئهم، ولم يحتقر أحدا أن يبلغ إليه رسالات الله، لأنه (ص) يعلم أن قيَم أهل الدنيا ومعاييرهم ليست هي المعاييرُ عند الله، فهذا عبد الله بن مسعود راع للغنم من بني هذيل، وهو حليف في بني زهرة من قريش حرص رسول الله (ص) على هدايته فآمن واتبع وصدَّق، وكان من أفضل هذه الأمة، حتى إن رسول الله (ص) قال فيه: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، كان نحيفا رقيقا لفقره، فصعد في شجرة فرآه بعض أصحاب رسول الله (ص)، فضحك بعضهم من حموشة ساقه أي من رقة ساقه، فقال رسول الله (ص): أتضحكون من حموشة ساق ابن مسعود، فلهي والله عند الله أثقل من جبل أحد، فالمعايير التي عند الناس ليست هي المعايير عند الله، بل قد يُرَى الرجل الذي لا يعرفه أحد ولا يؤبه له وهو عند الله يوزن بالآلاف، ويرى الرجل الضخم السمين لا يساوي عند الله جناح بعوضة، وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي (ص) قال: يؤتى بالرجل الضخم السمين يوم القيامة لا يساوي عند الله جناح بعوضة، لذلك اتصل رسول الله (ص) بمن يثق بهم ثلاثَ سنين لا يدعو إلا من يثق به، وهذا يدلنا على أهمية الثقة بين الناس، فمن المهم أن تتصل القلوب وأن يقع بينها التعارف، وأن يقع بينها الانسجام والتفاهم، فإن ذلك معين على تقبل الحق وسماعه، فقد مكث رسول الله (ص) ثلاث سنين لا يدعو إلا من يثق به، وقد فعل ما فعل من سبقه من الأنبياء، فقال: من أنصاري إلى الله فاستجاب له الذين أراد الله بهم الخير من ذلك الجيل المشرف فاجتمعوا حوله، وأول ما بدأ به رسول الله (ص) صياغة الرجال، فقد بدأ بتكوين أولئك القوم وتربيتهم على خلاف مفاهيم الجاهلية، فأزال من أذهانهم كل ما يتصل بالجاهلية، فتلك المفاهيم الخاطئة التي كانت سائدة في الجاهلية عالجها رسول الله (ص) حتى محاها بالكلية، ولذلك قام فيهم خطيبا ذات يوم فقال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتفاخرها بالآباء، فقد أذهب الله عنهم ذلك بالكلية، وأصبح الرجل منهم يعرف أن أباه عدوٌّ له، وأن أخاه عدو له، إذا لم يسر معه على طريق الحق، ولهذا أنزل الله فيهم، ﴿لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان﴾، هؤلاء القوم انظروا إلى الفرق الشاسع والبون الكبير بين حالهم وحال أهل الجاهلية الذين كانت القبيلة بكاملها تقاتل من أجل نصرة فرد من أفرادها ظالم وقع في ظلم سافر، ومع ذلك تنصره القبيلة بكاملها، فإذا غضب، غضب لغضبه سبعون ألفا لا يسألون مما غضب كما قال الأحنف بن قيس، فهم بعد هذا أصبحوا يقاطعون ويقاتلون آباءهم وإخوانهم وأبناءهم وعشيرتهم في ذات الله عز وجل، وتخلصوا كذلك من كل مظاهر الشرك بالكلية، فهذا عمر بن الخطاب الذي كان يصنع صنما من التمر ويسجد له فإذا جاع أكله، أصبح بعد إيمانه يقول للحجر الأسود الذي به شرف وشرف آباؤه، والله إني لأعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله (ص) يقبلك ما قبلتك، تغيرت المفاهيم التي كانت سائدة لديهم، فأصبحوا جميعا يصرحون بعداء ما كان آباؤهم يعبدونه من دون الله، فهذا خالد بن الوليد الذي كان يقاتل قائدا من أجل نصرة اللات والعزى بعثه رسول الله (ص) بعد إيمانه ليقطع شجرة العزى، فلما قطعها ضرب في جذعها بالسيف فخرجت له عجوز من الجن ثائرة الرأس تدعو بالويل والثبور، فأتبعها السيف حتى قتلها وهو يقول: «يا عز كفرانك لا سبحانك** إني رأيت الله قد أهانك» تخلصوا من كل مظاهر الشرك بالكلية، ثم تخلصوا كذلك من الأخلاق والقيم السيئة التي نهاهم الله عنها، فقد أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله (ص) في التحذير من مفاهيم الجاهلية،﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم﴾، فأهل الجاهلية الذين لم يؤمنوا ولم يصدقوا برسول الله (ص) هم الذين أصمهم الله وأعمى أبصارهم وختم على قلوبهم، فلا يمكن أن يعرفوا معروفا ولا أن ينكروا منكرا، وهم شر الدواب عند الله كما وصفهم الله بذلك، فلم يجعلهم من جنس البشر، بل قال: ﴿إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون﴾، وقال فيهم: ﴿إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون﴾، كذلك جعل هؤلاء القوم أنفسهم وقودا لهذه الدعوة، فرضوا أن يقدموا أرواحهم لله عز وجل، وأن يجاهدوا في سبيله بكل ما يملكون، عندما آمن مصعب بن عمير كان أعز فتى في قريش، وكانت أمه من أغنى النساء في مكة، فكانت كل يوم تشتري له ثوبا جديدا غير الثوب الذي كان يلبسه بالأمس، ولا يأتي نوع من أنواع الطيب إلا كان مصعبٌ أول من يستعمله، فلما أسلم وهو فتى شاب من أحسن ما يكون الفتيان وكان يشبه في خلقه برسول الله (ص) حبسته أمه بين أربعة جدران وعذبته بأنواع التعذيب، وقطعت عنه كل جرايته، وخلعت عنه كل ملابسه من أجل كلمة واحدة وهي أن يكذب بما جاء به محمد (ص)، فامتنع من ذلك وصمد وصبر على هذا المنهج، حتى كان أولَ سفير في الإسلام وأول إنسان عهد إليه ببناء دولة الإسلام، فكان أول من هاجر إلى المدينة من المهاجرين، وكذلك فإن عبد الله بن أم مكتوم كان رجلا ضريرا أعمى، ولكنه كان مستنير البصيرة حي القلب مقبلا على الله محبا للخير، فلما بعث الله محمدا (ص) جاءه فآمن وصدق، ثم لم يزل يغدو عليه كل يوم يريد أن يتعلم من دين الله كل ما ينزل وكل ما يتجدد، وكان رسول الله (ص) يواعد بعض علية القوم من المشركين الذين يأتون لمجادلته ويأتون للرد عليه، فكان من ردهم عليه أن يقولوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وهذه سنة سالفة لمكذبي الرسل فقد قالها مكذبو نوح عليه السلام، ثم لم يزل مكذبو الرسل يرددونها، فيظنون أن المعيار في الفضل هو بكثرة المال والولد، فيقولون لم يتبعك الوليد بن المغيرة، ولم يتبعك العاص بن وائل، ولم يتبعك أبو حكيمة زمعة بن الأسود، ولم يتبعك عمرو بن هشام ولم يتبعك عتبة بن ربيعة، وإنما اتبعك ضعفاء الناس وفقراؤهم، وكانوا يرون أن هؤلاء لا يمكن أن يحصل منهم خير ولا نصرة، ولذلك قال عروة بن مسعود رضي الله عنه يوم الحديبية عندما قدم سفيرا عن قريش إلى رسول الله (ص)، قال له: يا محمد إني أرى قومك قد لبسوا جلود النمور وصحبوا العوذ المطافيل، يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وما أرى معك إلا أُشابة من الناس، جدير أن يفروا عنك ويتركوك، يظن أن أولئك القوم الذين ليسوا أكثر الناس مالا ولا أولادا ولا أكبرهم مكانة اجتماعية بين الناس يمكن أن يتفرقوا عن رسول الله (ص) ولا يمكن أن ينصروه، وهذا بمفاهيم أهل الجاهلية، ثم إن عبد الله بن أم مكتوم جاء إلى النبي (ص) في وقت مجيء الوفد من قريش لمجادلته ومناظرته، فلما دخل عليه استحيا رسول الله (ص) من وجوده مع أولئك القوم الذين يريدون المناظرة ويحتجون عليه بأنه لم يصحبه إلا الضعفاء، فعبس رسول الله (ص) في وجهه يريد التخلص منه في ذلك الوقت حتى يمضي علية القوم، فعاتبه الله في كتابه في شأن ذلك الرجل العظيم، فأنزل الله فيه ﴿عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى﴾، فَزَكَّى الله عبدَ الله بن أم مكتوم وجعله من خيرة الناس، فكان ثاني من هاجر إلى المدينة بعد مصعب بن عمير، وقد ولاه رسول الله (ص) على المدينة في بضع عشرة غزوة، كما في الصحيح، يوليه على المدينة وعلى إمامة المسجد النبوي والخطابة فيه لأنه عاتبه فيه ربه سبحانه وتعالى وشهد له أنه زكاه، ثم لما تَوَفَّى الله رسوله (ص) ضاقت الأرض بما رحبت بعبد الله بن أم مكتوم لشدة محبته لرسول الله (ص)، فحرص على الشهادة في سبيل الله ليلتقي برسول الله (ص)، فلما بعث أبو بكر رضي الله عنه أول جيش إلى العراق تجهز ابن أم مكتوم وخرج فيهم، ولم يزل يقاتل ويتعرض للموت حتى كان يوم القادسية، فدعا الأمير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: يا سعد إني رجل ضرير لا أرى شيئا أرهبه فأعطني اللواء فلن أزال أتقدم حتى ألقى الله أو يفتح للمسلمين، فأعطاه سعد الراية فما زال يتقدم بها والفُرْسُ بين يديه وعن يمينه وعن شماله لا يبالي بهم، حتى لقي الله شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، إن ذلك الجيل الأول رجالا ونساء وكبارا وصغارا حققوا من الأمثلة مثل هذا الذي حققه عبد الله بن أم مكتوم، فما منهم أحد إلا وقد كان أشد الناس حبا لرسول الله (ص) وإجلالا له واتباعا له وتصديقا بما جاء به وقناعة وإيمانا بتحقق وعد الله الذي وعده به، ولذلك لما رجع عروة بن مسعود إلى قريش قال: يا معشر قريش لقد زرت النجاشي في ملكه وكسرى في ملكه وقيصر في ملكه، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، فوالله إنهم حوله لكأن على رءوسهم الطير، وإذا امتخط لم تقع مخاطته إلا في يد رجل منهم فيدلك بها وجهه ورأسه، وإذا تكلم أصغوا لكلامه وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، فقد كانوا يعظمون رسول الله (ص) التعظيم الذي أمرهم الله به في كتابه، فقد قال الله تعالى: ﴿إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا﴾، فكانوا يعزرونه ويوقرونه كما أمرهم الله بذلك، وكانوا يفدونه بكل ما يملكون، فهذا خبيب بن عدي بن جَحْجَبَا الأنصاري، خرج غازيا في بعث الرجيع فقاتل بني هذيل فأمسكوه أسيرا وجلبوه إلى مكة وباعوه لقريش، فحبسه قريش بمكة حتى خرج الشهر الحرام، ثم ذهبوا به خارج الحرم ليقتلوه، فلما نصبوا الخشبة ليصلبوه عليها، تقدم إليه أبو سفيان بن حرب فقال يا خبيب، أتحب أن ابننا محمدا عندنا نقتله وأنك في قومك في عزك ومكانتك، فانتفض خبيب وقال: والله الذي لا إله غيره ما أحب أن رسول الله (ص) يصاب بشوكة في مكانه الذي هو فيه، وأنجو أنا من القتل والصلب، وأعلن أبياته منشدا لها في قوله: «ولست أبالي حين أقتل مسلما** على أي جنب كان لله مصرعي** وذلك في ذات الإله فإن يشأ** يبارك على أوصال شلو ممزع» وسأل الله أن يبلغ سلامه رسول الله (ص)، فأرسل الله ملكا يبلغ رسول الله (ص) سلام خبيب وما لقي وأن الله سبحانه وتعالى رضي عنه وأرضاه، وكذلك فقد كان كل فرد من أفرادهم حريصا على أن يكون من الذين ينكون في أهل الجاهلية، ومن الذين يعلون كلمة الله بكل ما يستطيعون، ولذلك عجب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوم بدر عندما ابتدره الفتية الصغار من الأنصار يبتدرونه يقولون يا عم إذا رأيت أبا جهل فأرناه، فيقول وما حاجتكم إليه، فيقول كل فرد منهم، أريد أن أكون أنا الذي أقتله لما أعرف من عداوته لله ورسوله، فيعجب عبد الرحمن بن عوف من هؤلاء الفتية الصغار الشباب الذين يحرص كل واحد منهم أن يكون هو الذي يقطع رأس الكفر ويزيله بالكلية، وكذلك نساؤهم فقد كُنَّ عند هذا المستوى من تحمل الأمانة والسعي لإعلاء كلمة الله بكل ما يطلب منهن وبكل ما يستطعن تقديمه في سبيل الله وإعلاء كلمته، فتخرج المرأة مهاجرة من مكة إلى المدينة أربعمائة وستة عشر كيلو، في الحرار والحجارة وشدة الحر على رجليها لا تحمل نفقة ولا زادا حتى تصل، وقد خرج وفد من النساء مهاجرات ساخطات لشأن أهل الجاهلية، خرجن من مكة حتى قدمن المدينة على رسول الله (ص)، فأنزل الله فيهن في سورة الممتحنة، ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾، فشرفهن الله عز وجل بهذا التشريف العظيم الذي ما زال المسلمون يقرءونه في صلاتهم، ويتعبدون الله بتلاوته، وكذلك عبيدهم الذين كانوا يعانون من الظلم والمسكنة والمهانة في الجاهلية، فقد كان منهم من أعلى كلمة الله ونصره وبذل في سبيله ، ما لا يستطيع أحد أن يبذله اليوم، وكانوا بتلك المنزلة العالية، حتى إن أبا ذر يوم قدم على رسول الله (ص) سأله فقال يا محمد من تابعك على هذا الأمر؟ قال: رجل وامرأة وعبد وصبي، كل شريحة من شرائح المجتمع خرج منها سابق هو أفضلها فكان من أتباع رسول الله (ص) إذ ذاك، فالرجل أبو بكر والمرأة خديجة بنت خويلد، والعبد بلال والصبي علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك الحال بالنسبة للغرباء الذين أتوا من ديار بعيدة، فهذا صهيب الرومي كان بمكة وكان تاجرا ثريا من الأغنياء، وكان كبير السن قد بلغ أكثر من المائة، وكان راميا معروفا لا يخطئ في رمايته، فلما أراد أن يهاجر إلى الله ورسوله أراد قريش منعه من ذلك، فجمع ماله فنثره بين أيديهم، فقال: يا معشر قريش ما ذا تبغون مني، فأنتم تعلمون أني شيخ قد بلغت أشدي وتجاوزت المائة، وليس بيني وبينكم رحم، وإن كنتم تطلبون المال فهذا مالي في وجوهكم، وإن كنتم تريدون ردي عن ديني فوالذي يحلف به صهيب لا يصل إليَّ أحد منكم حتى يخرج سهم من كبده، ونثر كنانته وفيها السهام وهم يعرفونه بالرماية، فتركوه وخرج مهاجرا إلى الله ورسوله، وكذلك عدد من الذين أتوا من أماكن نائية من أطراف جزيرة العرب عندما سمعوا بهذا النبإ العظيم ببعثة الرسول الكريم (ص) جاءوا يلتمسون ما جاء به من عند الله، وقد أخبرنا أحد هؤلاء بأمر عجب، ألا وهو عمرو بن سلمة رضي الله عنه، قال: كنت في قومي وأنا صبي صغير، فسمعنا بمهاجر رسول الله (ص) إلى المدينة، فكنت أتلقى الركبان وأتحسس الأخبار عن رسول الله (ص)، ولا يأتي وافد من قبل المدينة إلا سألته عما أنزل من القرآن، فكنت أحفظ كل ما بلغني عنه، فلما أسلم قومي وفدوا على رسول الله (ص) فأمرهم أن يجعلوا إمامهم أقرأهم لكتاب الله فكنت أقرأهم وكنت إذ ذاك صبيا صغيرا، فكنت أصلي لهم، أي أؤمهم في الصلاة، فقالت امرأة من نسائنا: غطوا عنا سوأة إمامكم، فاشْتَرَوْا لي ثوبا ألبسه، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بذلك الثوب، هذا الطفل الصغير، كان ذا همة عالية، فكان لا يرى راكبا من جهة المدينة إلا أتاه وسأله عما نزل من القرآن فحاول حفظه، حتى كان أحفظ قومه لكتاب الله وكان إمامهم مع أنه لا يجد ما يستر عورته من الملابس، لكنه عُلُوُّ الهمة وعلو القدر وعلو المنزلة عند الله عز وجل، إن ذلك الجيل قد رباهم الله وهيأ لهم الظروف ليخلعوا أمر الجاهلية بالكلية، فأنتم تعلمون حرص أهل الجاهلية وبخلهم وأن كل إنسان منهم لا يمكن أن يؤثر أحدا بخير، لكن ذلك الجيل الفاضل عندما حاصرهم أهل الجاهلية وحاربوهم وحبسوهم في الشعب لا يبيعون إليهم ولا يشترون منهم ولا يُنكحونهم ولا يَنكحون إليهم ثلاث سنين جعل الله لهم هذه البيئة الصالحة لمقاطعة أهل الجاهلية، حتى يتحقق فيهم قيم الإسلام، فلولا حصار الشعب لم يستطع أولئك القوم أن يحققوا قيم الإسلام تماما كما هي مثل الإيثار، فالإيثار الذي تحقق بينهم إذ ذاك إذا سمعه أحد الآن عجب له، تصوروا أن عددا كبيرا من الفقراء الذين لا يملك أحد منهم ثوبا ولا لقمة عيش وهم في حرب وهم محاصرون يحاصرهم الأقربون والأبعدون، ولا يستطيع أحد منهم أن يخرج لحاجة، يجد أحد منهم كساء أو جُبَّة مدفونا في الأرض فينفضه ويأتي به أصحابه، ولا يستأثر به دونهم، ويجد أحدهم جلدا يريد أكله وهو في غاية الجوع فيغسله ويأتي به أصحابه ليشتووه ويأكلوه جميعا، إنه الإيثار الذي أثنى الله به على الأنصار فيما بعد، يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لقد رأيتنا في الشعب مع النبي (ص) وقد اشتد بنا الجوع، فخرجت لبعض حاجتي فوقعت يدي على شيء، فإذا هو جلد، فأخذته فأتيت به أصحابي فغسلناه وشويناه وأكلناه، ويقول عتبة بن غزوان رضي الله عنه لقد رأيتنا بالشعب مع النبي (ص) وما منا أحد إلا وهو يعصب الحجر على بطنه من الجوع، ولقد خرجت ذات ليلة لقضاء بعض حاجتي فوقعت يدي على شيء فإذا هو جُبَّة، فنفضتها فأتيت بها أصحابي، فاقتسمتها أنا وسعد بن مالك ائتزرت بنصفها وائتزر بنصفها، ثم والله الذي لا إله غيره، لقد رأيت أولئك النفر وما منهم أحد إلا وهو وال على مصر من الأمصار، بعد هذا الأذى وهذا الحصار المطلق فتح الله لهم أبواب الفتح، واستجابت لهم الأمم لصدقهم مع الله سبحانه وتعالى، فنصرهم بالرعب وهيأ لهم الأسباب، فأولئك القوم الذين هم بهذا القدر من القلة كما وصفهم الله تعالى في قوله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، تخافون أن يتخطفكم الناس، آواهم الله ومكن لهم في الأرض، وأزاح عروش الملوك أمامهم، وجعل سيوفهم علامة على الرعب في وجوه الأمم كلها، ففتحت الأرض أمامهم، ولم يستطع ملك من الملوك ولا قائد من القادة أن يقف في وجه أضعف أولئك القوم، إنهم نصروا الله سبحانه وتعالى وصدقوا معه فنصرهم الله كما تعهد بذلك، فقد قال في كتابه: ﴿ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز﴾، وقال تعالى: ﴿ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين﴾، وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم﴾، وقال تعالى: ﴿كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز﴾، فكتب الله لهم الغلبة والعزة والتمكين، تعالوا بنا يا إخواني لحظة لنقارن وضعنا نحن مع وضع أولئك القوم، إن أحفاد هؤلاء القوم بعد أن فتحت عليهم الدنيا أبوابها انشغلوا عما شرف به أولئك القوم، فأصبح الرجل من أحفاد الصحابة يعيش هنا في هذه المدينة أو في غيرها من مدائن الإسلام لا يفكر إلا فيما يجمعه من الأموال، ولا يفكر بغزو في سبيل الله ولا إعلاء لكلمة الله ولا جهاد في سبيله، ولا أن يرعب عدوا من أعداء الله، ولا أن يذل عدوا من أعداء الله، ولا أن يقول كلمة الحق مدوية صارخة، ولا أن ينصر الله بأي موقف، يريد أن يعيش مائة سنة معافى في جسمه آمنا في سربه، لا يتعرض لأذى بمقال أو حال، ولا يتكلم أحد فيه، ولا يتلقى أي تهديد ولا أي أذى، هل هكذا عاش أولئك القوم؟ إن أولئك القوم الذين تحبون الاقتداء بهم وتريدون مجاورتهم في الفردوس الأعلى من الجنة ما نالوا ذلك إلا بهذا الذي بذلوه، وبهذا الجهد الذي فعلوه، فكيف تتمنون الأماني دون أن تسلكوا الطريق، إن هذا الطريق كل من سلكه قد تعهد الله له بأن يوصله إلى هذا المقام فقد انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن يرجعه إلى المكان الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة أو أن يدخله الجنة، لذلك إذا قارنا أوضاعنا مع أوضاع البعثة سنجد انتشارا للشرك في هذه الأرض، حتى بين المسلمين قد يفعل بعضهم من الشرك ما لا يظنه شركا، ونرى انتشار للفواحش والظلم، ونرى استبدادا على الناس، ونرى قطيعة للرحم، ونرى أن الغني يزداد غنى من غير حل، وأن الفقير يزداد فقرا كذلك لاستغلال الأغنياء للفقراء، يستغلونهم أبشع استغلال، ونرى كذلك الفقراء يزدادون فقرا لا يمكن أن يحقق أحد منهم ما هو مضطر إليه وما هو محتاج له، إلا بالعناء المبين والمشقة الكبيرة بل قد فرض على الناس من أنواع الظلم ما يجعل الذي يريد أن يعيش من حلال لا يستطيع ذلك إلا بالربا والمحرمات التي لم يأذن الله بها، ونرى كذلك إدبارا عن منهج الله وإعراضا عن سنة رسوله (ص) سائدا في كثير من البيئات، ونرى حرصا بالغا على جمع هذه الدنيا وحطامها كما كان أهل الجاهلية يفعلون، ونرى تناصرا بين الناس على أساس النسب القبلي كما كان في الجاهلية من غير قناعة بذلك من الناحية الدينية، لذلك كان لزاما علينا أن نراجع مسيرتنا حتى نعود إلى ما كان عليه ذلك الجيل، وحتى يحقق لنا الله ما وعدنا من النصر والتمكين في هذه الأرض، إن علينا عباد الله أن نراجع هذه المسيرة بالبدء بمدارسة ما جاء به رسول الله (ص)، والاستسلام المطلق له والأخذ به، وأن نعلم أن ما يصيبنا في سبيل ذلك ليس شرا لنا، فالمفاهيم التي ترسخت في أذهاننا لا بد أن نزيلها، فإن الذين قتلوا يوم أحد شهداء في سبيل الله وقطعت آذانهم وأنوفهم وبقرت بطونهم قد حكم الله بأنهم لم يمسسهم سوء، فكل ما أصابهم ليس سوءا عند الله عز وجل، إذ قد حقق الله لهم أعلى الدرجات، وخصص لهم مقامهم في الفردوس الأعلى من الجنة، وشهد لهم بأنهم شهداء في سبيل الله، ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يسبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين﴾ إن حال أولئك كان حال الصدق مع الله سبحانه وتعالى، ولهذا وقف عليهم رسول الله (ص) قبل موته بثمانية أيام فقال: إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا الله ما عاهدوه عليه، فترحم على أصحاب أحد وصلى عليهم وقال: إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا الله ما عاهدوه عليه، إن هذا المكان الذي ناله أصحاب أحد في الإسلام بالإمكان أن يناله الحاضرون اليوم والسامعون، فما هو إلا بالتضحية في سبيل الله والبذل لإعلاء كلمة الله وإيثار الآخرة على الدنيا، والأخذ بما جاء به رسول الله (ص) ونصرته والتمكين له مهما كلف ذلك، إن علينا عباد الله بعد مدارستنا، لما جاء به رسول الله (ص)، أن نزيل ما بقي عالقا بأذهاننا من أمور الجاهلية، فما نراه اليوم من حرص على الدنيا وما نراه من أخذها من غير حلها، وما نراه من فشو الكذب والغش، وما نراه من فشو قطيعة الرحم، وما نراه كذلك من المذلة لأعداء الله، وما نراه من الهوان لدى أمم الشر، كله من مظاهر الجاهلية الجَهْلاء، إن رجلا من أبناء المسلمين وقف في ملإ وناد عظيم من الناس في الأسبوع الماضي فذكر زعيما من الزعماء وقال: إن الناس لم يتفقوا على محمد (ص) ولكن أهل دولة كذا قد اتفقوا على هذا الزعيم الفلاني، تبا له كيف يقارن أحدا برسول الله (ص)، حتى لو كان من الصالحين، فكيف يقارن زعيما من زعماء الدنيا وظالما من ظلامها برسول الله (ص)، إن ذلك الملأ الذي قيلت فيه هذه الكلمة ودوت فيه في الأبواق، لم يستنكر أحد منهم، ولا وقف أحد منهم للرد عليه، بل قد أعجبوا بكلامه لأنهم جميعا يتسابقون في ميدان واحد هو ميدان النفاق، إن علينا معاشر المسلمين أن نتسابق في ميدان الإيمان، وأن يحرص كل واحد منا على زيادة قربه من الله سبحانه وتعالى قبل أن يسخط عليه، وأن نحاول إذا سمعنا من هذا الدين وهذا الهدي شيئا أن نكون من الآخذين به، فقد كان أولئك الجيل الصالح إذا سمع أحدهم كلمة واحدة مما جاء به رسول الله (ص) تمسك بها ولم يتركها بعد أبدا، إن مسلما أخرج في الصحيح عن عنبسة بن أبي سفيان بن حرب عن أخته أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله (ص) يقول: من صلى لله اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة، قالت أم حبيبة فما تركت ذلك منذ سمعته من رسول الله (ص)، قال عنبسة وأنا ما تركته منذ سمعته من أم حبيبة، فهكذا كان الحرص، إذا سمع الإنسان حكما واحدا أخذ به ولم يتركه وكان صادقا عندما يقول: فما تركته منذ سمعته، ولذلك حين قطعت رجل أحدهم في سبيل الله أخذها فقبلها وقال: هذه الرجل لم تحملني إلى حرام منذ خمسين سنة، فعلينا عباد الله أن نحرص على أن نتمسك بما نسمع عن رسول الله (ص)، وبما جاءنا من الهدي المبين الذي نؤمن به ونصدق، وأن نعلم أن سلوك هذا الطريق يحتاج منا إلى مجاهدة، وهذه المجاهدة تحتاج إلى تعاون فيما بيننا، فلا يمكن أن يسلك الناس هذا الطريق من غير أن يجاهدوا أنفسهم في سلوكه لكثرة المغريات والفتن المضلة، ولا يمكن كذلك إذا جاهدوا أنفسهم على سلوكه أن يستقيموا عليه وأن يستمروا عليه إلا بالتعاون على البر والتقوى فكل إنسان منا عرضة للنسيان وعرضة للفتن، وعرضة للضعف أمام الشهوة، وعرضة للضعف أمام الضغوط، لكنه إذا وجد من يتعاون معه فيذكره إذا نسي ويعظه إذا فتر ويرغبه حين الترغيب، ويرهبه حين الترهيب، ويعينه إذا احتاج إلى العون فإننا جميعا سننطلق إن شاء الله تعالى في طريق الحق، علينا عباد الله أن نحرص على الصحبة الصالحة المعينة على هذا الطريق، كما حرص عليها أولئك النفر، فقد جاء أعرابي فرأى ما هم فيه، فأعجبه وهو يعلم أنه لا يستطيعه، فقال: يا رسول الله الرجل يحب القوم ولَمَّا يَلْحَقْ بهم، فقال رسول الله (ص) أنت مع من أحببت، انظروا إلى هذا الأعرابي الذي جاء من غنمه وباديته وهو يحب أن يفعل ما يفعله أصحاب رسول الله (ص) وما يفعله رسول الله (ص)، ولكنه يعلم في نفسه العجز عن ذلك، فقال: يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال: أنت مع من أحببت، فإذا حرص الإنسان على أن يحقق أمر الله في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾ حرص على أن يكون مع الصادقين فإن الله يرفع مقامه ومنزلته بذلك الحرص، ويكون هو من المؤازرين إن لم يكن من الذين يحملون الثمر، فقد ضرب الله هذا المثل لهذه الأمة، في الإنجيل، فقال: ﴿كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار﴾، فالزرع يخرج شطأه في البداية فتخرج السنبلة التي تحمل الحب وهي ضعيفة ملتوية، لكنها يحيط بها السنابل من كل جانب، وتلك السنابل لا تحمل الحب لكنها تتحمل الضربات عن السنبلة التي تحمل الحب، فتحول بين الطفيليات وبين الوصول إلى الحب، وتؤازرها في وجه الرياح، وبذلك تكون مشاركة، فمن كان عاجزا عن أداء عمل لكنه يستطيع أن يناصر أهله بما يستطيع فإن ذلك كاف في تحقيق مأموله والوصول إلى مراده، حتى يكون ﴿كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه﴾، إن علينا عباد الله أن نعلم أن هذا الزمان الذي نحن فيه زمان الفتن المضلة، التي لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا دخلته، فعلينا أن نستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نحاول النجاة منها، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بتمسكنا بالهدي الأول، وأن لا نتجاوزه وأن نحرص عليه جميعا، فقد وعد رسول الله (ص) بأيام بين يدي الساعة المتمسك فيها بدينه كالقابض على الجمر، إنما ترونه اليوم هو الغربة الثانية التي أخبركم بها رسول الله (ص) في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء إما أن تكون خبرا وإما أن تكون دعاء، فقد تحمل على الخبر فمعناه أنهم قد طابوا، وأن الله اختار لهم طوبى، إما مقام في الجنة، أو منزلة عظيمة عند الله، أو أن يكون ذلك دعاءً من الرسول (ص) ودعاؤه مستجاب، فقد دعا لهم بأن يطيب ما هم فيه من أمور الدنيا، وأن ينالوا تلك المنزلة العالية في الجنة يوم القيامة، إن النبي (ص) أخبر عن خير كثير يكون في آخر هذه الأمة، وخرج إلى المقبرة يوما فأخذ عودا فنكت به في الأرض فقال: وددت لو رأيت إخواننا، قالوا أَوَلسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإخواني قوم آمنوا بي ولم يروني، للواحد منهم أجر خمسين، قالوا يا رسول الله منا أو منهم، قال: بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا، إننا لم ندرك صحبة رسول الله (ص) التي هي أفضل وأسمى وأكمل، فعلينا أن نحرص على إدراك أخوته حتى نكون من إخوان رسول الله (ص) الذين آمنوا به ولم يروه، فهم الذين يتحقق فيهم الخير الآخر الذي يكون في هذه الأمة، فهذه الأمة لن تعدم خيرا، وسيكون في آخرها خلافة على منهج النبوة، وقد صح عن النبي (ص) أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يقوم اثنا عشر خليفة، وقال كلمة فأسر بها، قال جابر بن سمرة فسألت أبي وكان بيني وبينه، فقال: قال: كلهم من قريش، وقد بين رسول الله (ص) أن تلك الخلافة على منهج النبوة كما في حديث حذيفة بن اليمان في مسند أحمد أن النبي (ص) قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون مُلْكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسكت، إننا عباد الله بأخذنا بذلك الهدي لا يمكن أن نلام بأننا قد نقدنا من سبقنا من العصور فيما بيننا وبين الصحابة، فما يفعله أقوام من المناظرة والمجادلة عندما يقولون إن الذين سبقونا من أهل القرن الماضي والذي قبله قد كانوا على خير وهم خير منا ولم يكونوا يفعلون هذا الذي تفعلونه إن هذه الحجة واهية، لأننا جميعا نحن وأهل القرن الماضي وأهل القرن الذي قبله وأهل القرن الذي قبله جميعا عيال على أصحاب رسول الله (ص) وأتباع لهم، ولا يمكن أن يأتي أحد بأفضل مما جاء به أصحاب رسول الله (ص)، ومن كان مقتديا فليقتد بالأفضل، وليس ذلك طعنا في الذين قبلنا، ولا نقدا عليهم، فقد أفضوا إلى ما قدموا ونحن مهمتنا أن نستغفر لهم وأن ندعو الله لهم، كما أثنى الله على اللاحقين من هذه الأمة بذلك، فالله سبحانه وتعالى قد بشر بأجيال آتية في هذه الأمة في عدد من آيات كتابه، فقد قال في سورة الحشر بعد ذكره للمهاجرين والأنصار قال: ﴿والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم﴾، فهذا حالنا مع كل السابقين، كل من سبقنا من آبائنا وأجدادنا والقرون السابقة نقول: ﴿ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم﴾، ومن بشارات الله بهذه الأجيال اللاحقة قوله تعالى في سورة الجمعة: ﴿وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم﴾، فهذه بشارة بالجيل الذي سيأتي، وآخرين منهم، أي من أتباع النبي (ص)، لما يلحقوا بهم أي أنهم سيلحقون، فلما لنفي الماضي المنقطع، معناه أن ذلك سينقطع فسيلحقون بهم، فهذه بشارة من الله سبحانه وتعالى بأجيال لاحقة في هذه الأمة فيها الخير العظيم، ويكفي من تشريفها أن الله سبحانه وتعالى وعدها باللحاق بالأجيال الأولى، لما يلحقوا بهم هذا إخبار بأنهم سيلحقون بهم، وهذا كاف من رفع القدر والمنزلة أن يوصفوا بأنهم سيلحقون بالأجيال السابقة من هذه الأمة وبالسابقين من المهاجرين والأنصار، إننا عباد الله في هذا البلد في غرب هذه الأمة الإسلامية وقد ورد في ذكر فضل غرب هذه الأمة كثير من الأحاديث، فقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي (ص) قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وهم أهل الغرب، فعلينا أن نحرص على أن نكون من أولئك الطائفة الظاهرين على الحق الذين هم من أهل الغرب حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وقد بذلنا ما عاهًدْنا الله عليه وصدقنا فيما وعدناه سبحانه وتعالى، وعلينا أن نعلم أن الله غني عنا وأنه سيعز دينه بعز عزيز أو بذل ذليل، وأننا إذا تراجعنا عن نصرة هذا الدين، فسيخرج الله من الأجيال من ينصره ولا يخاف في الله لومة لائم، كما قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم﴾، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. |
| السبت, 11 ديسمبر 2010 17:55 |
آخر تحديث للموقع: الثلاثاء, 12 نوفمبر 2024 13:54